البعد الفلسفي في شعر محمد بلمو

د. أبو علي لغزيوي
عندما نتحدث عن الشعر نتحدث عن الذات المرتبطة بالكون والحياة، لأن الشعر هو كون وحياة وبناء وتأمل. فالشاعر بلمو يمتح رموزه من رحم الفلسفة، سواء تعلق الأمر بالعنونة أو في معمارية القصائد، فبها يثري البياض ويطرب العالم، حيث تأخذ اللغة الشعرية براعتها الفلسفية بكل أبعادها الأنطلوجية، لأنه يسكن اللغة قبل أن تسكنه، وعبرها يؤسس برمجية لفظية توطد دعائم الرؤيا وترفض كل تجربة لا تتأسس على المعاناة، فبالنظر في أبعاد هذه الدواوين “طعنات في ظهر الهواء” “رماد اليقين”، و”صوت التراب”، سيدرك القارئ أن الكلمة لا تأخذ بناءها الإيحائي الرمزي إلا بتوظيفها توظيفا جماليا، فالقصائد تعلن عن شكواها كلما رن أنين برومتيوس، وكلما دنت من الولادة! كلما ضحكت ضحكة عشتار، هكذا ظل الشاعر يحاكم الواقع العربي بلغة فلسفية تتجاوز حدود الذاكرة، لتحيل على مفهوم التفلسف القصيدي في بعده العلائقي والتفاعلي وأيضا على المستوى البناء الهيكلي النظمي.
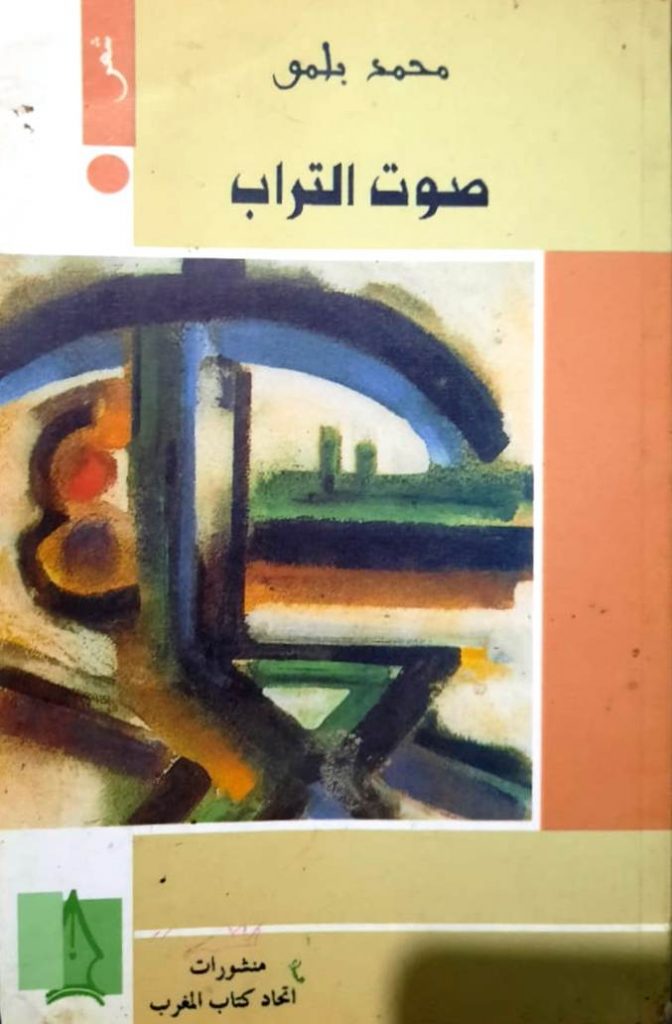
إذن فالشاعر يواجه التناقضات الأنطلوجية والرمزية في رؤية معرفية وفنية، تتجلى في الدواوين المذكورة، فهي الوجود الشعري والكوني والفردي والجماعي والقريب والمختلف، لأن العلاقة مع الذات الشاعرة بسياقاتها الواقعية والسياسية هي عبارة عن جدلية تفاعلية يحضر فيها اللغوي والرمزي والحب والكراهية. فعبر هذه الثنائيات التي تقسم جسدية الدواوين تتولد لنا إشكالات سواء على المستوى المعرفي أو على المستوى الإبداعي الشعري أو على المستوى الأنطولوجي، إذن هل معرفة العالم الشعري ممكن؟ وهل بإمكاننا النفاذ إلى الرؤيا الخاصة بالشعر؟ ولماذا حضور الأديولوجي والمعرفي والفني في شعر الشاعر؟
تشكل هذه الأسئلة بالنسبة لنا مرتبة عليا مفتوحة قابلة للمسائلة والمحاورة، فالذات الشاعرة هي موجود ضروري لوجود القارئ والناقد، لأن التفكير في شعره هو شرط لوعي الذات الباحثة عن السكون والصمت الذي يذب في أعماقه، لأنه يرغب بالاعتراف بهذا الجسد المقموع فينا كما يقول نيتشه، فنشأة العلاقة الحوارية مع الدواوين هو انتزاع واعتراف بالحرية الكامنة وراء هذا الكون الشعري، فالشاعر بلمو هو هذه الآنا الذي يحاكم نفسه لكي يؤسس أناه المثلى، فالمبحوث عنه هو هذا المضمر والكامن وراء الكلمات والحروف والأشياء، إنه جسد ولغة ونفس ووطن وحب وموت وحياة وغربة وضياع وتفكيك وتوليد. إنها اللوحات التي رسمها الشاعر في دواوينه لتشكل هذه الآنا والوجود والإنسان، لأنه يبني اللحظة الهاربة من وعيه إلى لحظة لا واعية قصد تحقيق ولادته الجديدة.
فالشاعر بلمو يستوطن كل اللغات ببراعة فنية من خلالها يقرب لنا كل الفلسفات التي تمهد لهذا الجسد الشعري والهامشي باعتباره تاريخ للرغبات والتضحيات.
فالدواوين هي حمولة فكرية وأدبية ونقدية تعمل على تحطيم كل الأقانيم الرومانسية الأفلاطونية والذاتية المطلقة التي أعلنت إنتماءها للميتافيزيقيا، فالشاعر يخلق أساطير تراتب لكي يقحم الفكر بثنائيات متناقضة مثل الروح والجسد والمعرفة والحياة، والتي أفضت في كل ترسباتها وفقا للتصور الشعري أدت إلى كبث هذا الجسد، وعطلت مداركه الإبداعية وصادرت الحياة بتسميات جوفاء دون صياغة أي مضمون فكري مغلق أو إيديولوجي مطلق أيضا. هذه المرجعية الفلسفية تحيل على الإطار العام الذي يحدد مجال بلمو، لأنه يظهر المعرفي والجمالي أكثر ما ينم عن قوة تقليدية. فالشاعر إذن ساير أدونيس في متونه الملقحة بالفلسفة وبالهموم الإنسانية، هكذا ظل بلمو أدونيسي في شعريته التي تستمد تشكلها من مختلف الفلسفات العالمية.
لذا يبقى هو مغلفا بمراس إبداع كوني يريد خلخلة المتناهي لكي يزرع الاختلاف كمقوم أساسي وجوهري في كل كتابة شعرية، فدواوينه هي شهادة ميلاد جديدة تعيده إلى التربة والهواء والنار والماء، كلها عناصر تخلق لنا حواس لمواجهة العولمة والإنسان والوجود، إنها ثمرة فكرية وشعرية كما عند عباس محمود العقاد أو عند أدونيس، وأمل دنقل لأنه يقاوم النهائي والثابت من أجل إيجاد هذا المتحرك، أصالته المفقودة في بنية العقل العربي، ف”صوت التراب” و”طعنات في ظهر الهواء” و”رماد اليقين” … كلها صيحات إبيستمية تحاكم الجوانب الفنية والدلالية في شعرنا العربي المعاصر الذي لم يستطع أن يخلق له استقلالية فكرية حرة دون حضور وعي أديولوجي زائد، فبلمو يملك وعيا ممكنا كما أدونيس ليخاطب اللغة والذاكرة والتراث والإنسان والتربة والوطن من أجل إنشاء علاقة بديلة حول نشأة الذات والوظيفة الجمالية في إطار فكري ومذهبي جديد.
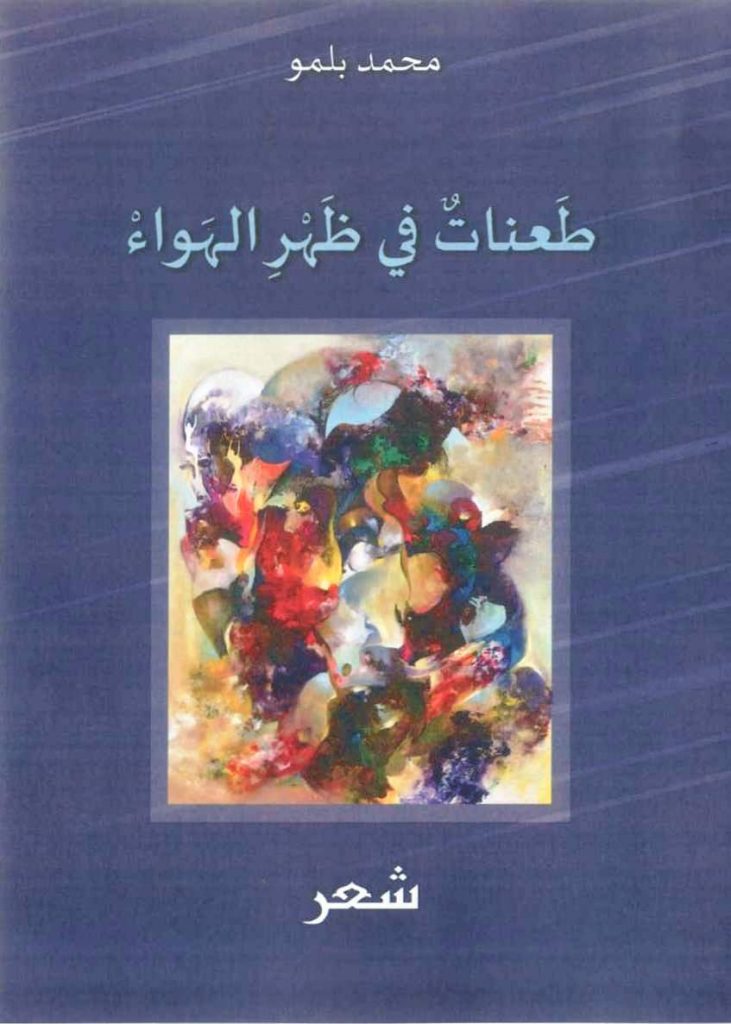
يبقى بلمو كشاعر يقدم لنا جانبا من جوانب العلاقة بين الفلسفة والشعر، لأن هذا الأخير هو الذي طور هذا الوعي وأمده للفيلسوف من أجل محاكمة الوعي السائد، إنه فيلسوف قبل أن يكون مفكرا كما يقول صلاح عبد الصبور. وتبقى هذه الكتابة الشعرية لذا بلمو مفتوحة على كل القراءات، لأنها هي المؤجل والضمني حيث تنتظر تفكيك شرايينها وتلقيحها بلغة إيحائية تستجيد لتطورات الكتابة المعاصرة.





