الديمقراطيات الغير المكتملة ومبادرات للإصلاح

نعيد هنا مجددا، طرح إشكالية العمل السياسي العربي والتنظيمات السياسية الراديكالية وأثرها على المسار الديمقراطي العربي. وهي إشكالية نظرية قديمة، وهي إجابة أيضا لفكرة: إعطاء السلطة لأعداء الحرية والتعددية، والتاريخ يذكرنا يوميا كيف تم تسليم السلط لحكومات تقودها أحزاب استبدادية راديكالية، وكم كان الثمن باهظا ومدمرا.
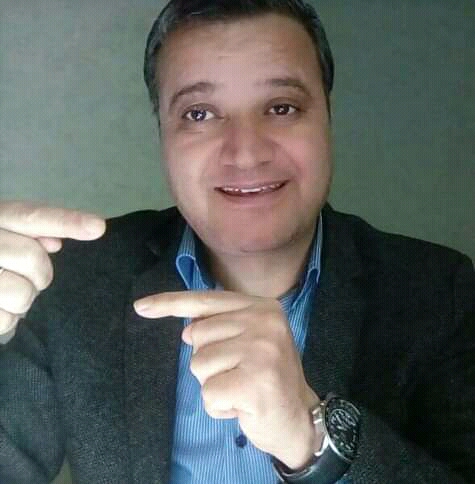
فكل البلدان العربية عايشت هذه الإشكالية التي اتخذت لها أشكالا شتى أحيانا سلمية وأحيانا كثيرة فظيعة ودموية. فالكثير من الحركات الراديكالية كانت دينية أو لا دينية عرفت بخطاب مزدوج، كانت تتعالى منه أحيانا نبرة حقوقية ومطالب عدالة صادقة، وأحيانا كانت نفس الأحزاب تلعن الديمقراطية وتتهكم على المسار السياسي برمته.
ومن جهة أخرى قبل الديمقراطيون، وباسم الديمقراطية، إجهاض تجارب ديمقراطية عديدة في عالمنا العربي، وفضلوا الاحتماء بأنظمة استبدادية مما جر العديد من الشعوب نحو الضياع والفوضى.
فما وقع في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي وما يقع في العديد من بقاع الوطن العربي، وما يمكن أن يقع في المستقبل، من استعمال الاستبداديين للديمقراطيين من أجل الوصول إلى السلطة ثم الانقلاب على مبادئ التعايش الديمقراطي واحترام التعددية الفكرية والسياسية. كل ذلك يطرح تساؤلين اثنين: الأول يتعلق بالخيار الديمقراطي نفسه، والثاني بطبيعة الآليات التي توصل إلى السلطة والحكم.
وحتى تحقق الديمقراطية انتقالها الحقيقي من العنف إلى الرمز، لا بد من سجال قوي وحقيقي بين كل الأطراف كيفما كانت انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية. ولا يجب أن يظل أي طرف خارج اللعبة وإلا سيظل يشكل خطرا ويشكل أيضا إقصاء غير مبرر ولا يخدم العملية السياسية وتطويرها. فالكثير من الأنظمة تتقن فن اختيار التابعين وإقصاء الآخر من اللعبة السياسية، وهو ما يسيء للديمقراطية كهدف أساس.
فاللعبة السياسية في عالمنا العربي عرفت على أنها كالمباريات الرياضية المعروفة النتيجة مسبقا، فالانتخابات هي مجرد معركة اتفق على نتائجها مند البداية. فالمسلسل الديمقراطي بحاجة لأناس لديهم خيارات وقناعات عميقة، وتفصلهم جزيئات نظرية وتوجهات سياسية.
العملية السياسية بحاجة لتفسير التناقض الموجود بين : ضرورة الدفاع عن النفس وضرورة الوفاء للمهمة الديمقراطية، وعلى جميع الفرقاء القبول بقواعد اللعبة لنجاح مسلسل البناء الديمقراطي وهي : الحق في الرأي المخالف ، وفي التنظيم الحزبي ، والتجدد السلمي للسلطة ، واستقلال القضاء.
لكن هناك من يعترض على هذا التصور لوجود حركات إيديولوجية راديكالية لم تتقبل بعد التغيير الحاصل، أو لأنها لا تثق بفاعلية هذا الانتقال وهي تفضل دوما المعارضة من أجل المعارضة فقط.
وداخل العملية السياسية الاعتراف بالآخر لا يمكن أن يتوقف على الخيارات الإيديولوجية أو المرجعية الفكرية لهذا الحزب أو ذاك، ولا على مقدار قربه وولائه للسلطة، وإنما يتوقف على مبدأ قبول أو عدم قبول اللعبة الديمقراطية وتقبل العمل وفق أهداف الديمقراطية وآلياتها من أجل مصلحة الوطن والشعب.
تدافع الديمقراطية عن نفسها من جهة بجلب أكبر عدد ممكن من الأطراف الاجتماعيين والسياسيين للحرب الرمزية، وجعلهم يتضافرون لتحقيق الأمان الجماعي. ومن جهة أخرى، تراها مضطربة لمواجهة الحرب العنيفة حين تقع بين ظهرانيها، بالعنف المفروض عليها.
علما أنها يمكن أن تنجح في تهميش الفعل العنيف بالاقتصاد الشديد في ردة الفعل، واحترام مبادئ الحرية، ومراقبة تعامل الجهاز الأمني مع كافة الأخطار المهددة له، وأيضا بذل جهد أكبر وحقيقي للقضاء على أسباب العنف الاجتماعي بالقضاء على: الظلم الطبقي، العمل على انعدام حالات اليأس والبؤس العميقين اللذين يفسران الانتفاضات الشعبية ، إذ نادرا ما يكون هذا التمرد العنيف نتيجة هواية أو جنون أو حب حقيقي للعنف.
إن أولى الضمانات التي يجب أن تكون واضحة صريحة في العمل السياسي العربي هي اعتراف كل تنظيم سياسي بأركان بناء المسلسل السياسي الديمقراطي التي تحدثنا عنها، وأن يكون بندا في وثيقته التأسيسية. ويمنع على الجميع الاحتجاج بمرجعيته الخاصة أو بمقدساته الإيديولوجية لرفض هذه المرتكزات.
كما يجب فرض قانون الديمقراطية داخل الحزب نفسه، فكل حزب استبدادي التنظيم في داخله سيغتال الديمقراطية عاجلا أم آجلا إن وصل للسلطة. ومن حق الدولة كأي مؤسسة اجتماعية أخرى، رفع دعوى ضد كل تنظيم سياسي ينحرف باتجاه عبادة الشخصية داخله أو حين يقوم بطرد المخالفين في الرأي بين أعضائه، أو حين يدعم أي شكل من أشكال العنف أو يدعو له، أو حين يفتقد لعملية انتخابية نزيهة داخل مكاتبه حين يتعلق الأمر بالتداول السلمي على المسؤولية. لأنه ببساطة، الديمقراطية لا تتحقق بالأشكال الاستبدادية، وما يقع داخل التنظيمات والحركات والأحزاب هو نسخة لما سيقع داخل أطر الدولة إذا استلم هذا الحزب الحكم.
لكن حين تبنى الديمقراطية فهي نتاج بالأساس لكل القوى الاجتماعية التي تساهم جميعها في عملية إنسانية المجتمع. وهنا نحن بحاجة إلى عمل كل المنظمات التي تتعامل مع المشاكل اليومية للمجتمع لأنها تكون أقدر من غيرها على معرفة القوانين المعيقة لتطور المجتمع، والقوانين الأنجع لتفادي المشاكل التي قد تحدث.
كما أن عملية التأسيس والبناء هذه بحاجة إلى عقلية تقييمية دائمة ومستمرة، مما لا شك فيه أن الجدال الحاد الذي يحصل بين مختلف الفرقاء السياسيين أيام الحملات الإنتخابية، والذي يصل حد العنف والمعارك هو نوع من التقييم العنيف، في حين أنه بإمكان المنظمات المدنية أن تكون أداة الدولة الديمقراطية في عملية التقييم العقلاني والمتواصل، لأنها أدرى من السياسيين بالنتائج الملموسة للسياسات المتبعة. ولا يعني هذا أن ليس للدولة حق التقييم والمراقبة وإنما أن يكون تقييمها تقييم علوي مصاحب ومكمل للتقييم المنظماتي لكل هذه المؤسسات، وذلك حتى تسود النجاعة والديمقراطية بين كل الأجهزة والتنظيمات .
وتستعمل نتائج التقييم المتواصل لإجراء إصلاحات دائمة وتعديل مسار المؤسسة، سواء أكانت اجتماعية أو سياسية أم اقتصادية… وكل هذه العمليات تستوجب النزاهة والشفافية والوضوح، أي إعلاما ديمقراطيا وفعالا أيضا.





