
لمفهوم الأمن ودلالاته اختلاف كبير بين الدول الحديثة أو المسماة ديمقراطية وبين ما هو عليه في بلادنا العربية التي بنيت على القمع والقهر والتسلط الشمولي، حيث كان مفهوم الأمن المقصود في العالم العربي هو العمل على تأمين وضمان بقاء النخب الحاكمة في سدة الحكم لأطول مدة ممكنة، في حين يأتي العمل على تأمين حاجيات المواطن وتحقيق متطلباته المعيشية من أمان وكرامة في الدرجة الثانية.
فالأجهزة الأمنية في البلدان العربية عملت لعقود على حماية النخب الحاكمة وصرف أموال طائلة للحفاظ عليها وعلى التسليح، عوض التركيز على الإنفاق على التعليم والإستثمار في العلم والحث على الإنتاج والإبداع. فبالرغم من الثروات الهائلة التي توفرت للبلدان العربية إلا أنها لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح الذي يعود بالنفع على المواطن، بل تم صرفها في أمور ثانوية وشكلية جعل من هته البلدان قابعة في قعر الدول المتخلفة.
الأمن كمنظومة نجده حتى في الدول المتقدمة لكنه يختلف من حيث الأسس والأدوات والفكر، في هذه البلدان الأمن يسعى لحماية المواطن والحرص على سلامته ويمتلك الوعي الوطني والعلم وخاضع للمحاسبة والقانون والمراقبة المستمرة. في حين يستخدم دوما مفهوم الأمن في البلاد العربية كضرورة لحماية الوطن والمواطن لكنه في النهاية لا يحمي سوى الأفراد الحاكمين ويعمل على بقاءهم.
فالجهاز الأمني من المفروض أن يكون فقط في خدمة الوطن والمواطن وليس لفرد أو نخبة، ويكون خاضع لقوانين شفافة ومراقبة مستمرة ومحاسبة وليس مفروض بالقوة وتتحكم به جماعة معينة الهدف منه حينئذ جعل المواطن في حالة خوف مستمر من الأخر في حين الهدف الأسمى هو أمن وراحة المواطن.
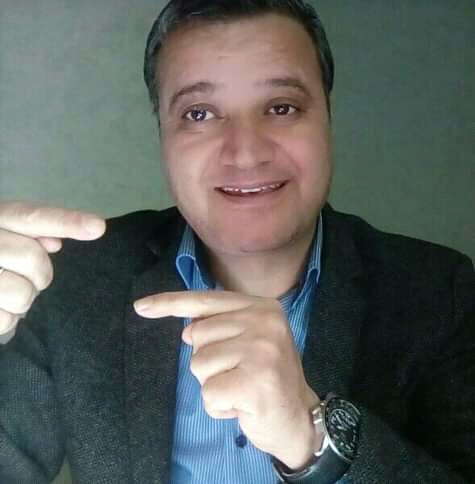
المواطن العربي الذي لم يعش طويلا طعم الدولة الحقيقية لأن كل المحاولات لم تدم وباءت بالفشل، بحيث نجده شاكيا دوما وناقما على وضعيته ومهموما ويحس بالاحتقار، وينتهز أول فرصة للرحيل دون تردد وكأنه يفر من الجحيم إلى النعيم. فهي أنظمة أمنية استخدمت أحيانا القمع والقهر والإذلال والاستعمال الغير القانوني للعنف الجسدي واللفظي، فهو نظام يلغي الذات الفردية ويجد المواطن نفسه خارج المشاركة السياسية وكأنه غير مرغوب فيه.
فالأمن واجب وحق وطني كرؤية قانونية تهدف لحماية الفرد ضد القمع والتعذيب، ومسؤولية أيضا في بناء الوطن وحمايته ليتسنى للجميع العيش بكرامة وسلام بحقوق وواجبات .
ومعظم الأجهزة الأمنية في الوطن العربي تعمل فوق القانون وتعتبر نفسها الأداة التشريعية والتنفيذية للدولة أي للنخب الحاكمة، لهذا يجد الفرد العربي نفسه في صراع يومي مع الذات فهو لا يشعر بالحماية القانونية وبحقه الطبيعي في الحياة والعيش الكريم لذا نجده دوما متذمرا وغير راض عن واقعه وعن نفسه.
وحتى في الدول العربية الغنية، فالفرد هناك لم يصل بعد إلى صفة المواطن الحقيقي المشارك والفاعل في الحياة السياسية وفي الحكم ووضع السياسات، فقد ضل مستهلكا بامتياز ومستفيدا من وسائل وإمكانيات العيش لكنه لم يحقق بعد ذاته وحقه في فرض أرائه وأفكاره والعمل على إيصالها للنخبة الحاكمة.
فمعظم الأنظمة العربية مارست منذ الإستقلال مختلف أنواع العنف الرمزي والمادي لديمومتها وبقاءها، وتناست الإصلاحات الضرورية لصيرورة المجتمع ودوامه أيضا. فهل كان هذا الخلط بين مفهوم الدولة الأمنية والدولة الوطنية مقصودا لإنشاء دولة قمعية لن تؤدي إلا للخراب، أم أن نخبنا السياسية لم تكن قادرة على فهم أصول الحكم والسياسة.
فهي أنظمة غالبيتها استبعدت الحوار والعقلانية السياسية والقيم والمبادئ الوطنية والتداول السياسي للسلطة الذي يهدف إلى مشاركة واسعة وتناوبية للفرد والجماعات خدمة للمجتمع والوطن كله، سياسيات وسلط تم تسييرها بعقول تفتقر للوعي والبعد الإنساني وافتقدت الوطنية والمصداقية ولم تهتم إلا بشؤونها الضيقة وحساباتها السياسية النفعية.
فحين نستبدل هذه العقول السياسية المسيطرة بعقول واعية لها حسها الوطني والغيورة على مصالحه وحقوقه والتي تعي جيدا الهدف من وجودها في السلطة، آنذاك يكون لنا أفراد وجماعات متحررة من الخوف من التغيير الإيجابي وتعي حقوقها الوطنية وواجباتها، وتحترم القانون الذي شاركت في وضعه والعمل على تطوير وسائل عيشها وضمان راحتها وكرامتها.





