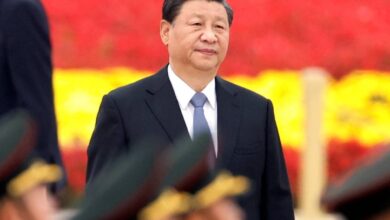تابعت الحوار المطول الذي أجراه الصحفي الرصين يونس مسكين مع القيادي الإسلامي والوزير السابق الأستاذ مصطفى الرميد، وقد كان حوارا سلسا ودسما في آن، لدرجة قد لا تنتبه معها لطول مدته التي تقارب الثلاث ساعات ونصف.
الرميد تنقل في حواره بين ثلاث قبعات، الأولى بصفته واحدا من أبناء الحركة الإسلامية، التي قدم فيها روايته لما عايشه من ظروف نشأتها وتطورها، ولم يخل هذا الحكي التاريخي من نزعة ذاتية تجعل المتلقي يتصوره محورا جوهريا لأكثر التحولات التي طرأت على الجسم الحركي الإسلامي، شأنه في ذلك شأن أغلب رواة الحركات الإيديولوجية إسلامية كانت أو غيرها، ممن يروون تجاربهم الخاصة بمؤثراتها وأحداثها وشخوصها وانفعالاتها النفسية فتخال وأنت تستمع إليهم أنها الرواية الوحيدة الصحيحة، وأن من يرويها اكتشف وحده كروية الأرض، ومع عدم إنكار الأدوار التي لعبها في تلك المرحلة، بشهادات استقيتها شخصيا من عشرات ممن كانت لهم أيضا أدوار إبانها، إلا أنه ربما يكون قد نسي، أو تناسى، أنه راو قد ينفرد بتفصيل بسيط هنا أو هناك، لكنه حتما لا يملك كل التفاصيل وسط تعدد الرواة، وإن تاريخا متشعبا كتاريخ الحركة الإسلامية لا يمكن روايته من مصدر واحد لأنه وببساطة تاريخ ساهم في صناعته، فضلا عن أبناء الحركة بمختلف تلاوينها وأطيافها ومراحلها، الواقع نفسه الذي لا يمكن أن تسمى الحركة حركة إلا بالتفاعل معه ومع كافة أطرافه المجتمعية والسياسية الرسمية والشعبية.

ومن ثم فإن الحركة الإسلامية هي نتاج تفاعل بين عدد من المكونات، فالزمن عامل حتمي في تشكلها لأنها تخضع لقانون التطور التاريخي مثل باقي الديناميات الفكرية والسياسية والاجتماعية الإنسانية، والبنية الداخلية لكل حركة عامل أساس من عوامل نشأتها وتطورها ونضجها ونجاحها أو إخفاقها، وتتمثل هذه البنية في أدواتها الفكرية والتربوية وخطابها الدعوي والسياسي، ومدى قربها أو بعدها من الحالة السياسية السائدة أي علاقتها بالبنية الحاكمة للبلد، هذه العلاقة التي يترتب عليها الاصطفاف الذي تختاره الحركة موقعا لنضالها الاجتماعي والسياسي، من حيث الموالاة أو المعارضة، ومن حيث طبيعة التحالفات التي تنشئها مع القوى التي ترى أنها تتقاسم معها كل أو بعض رؤاها ومطامحها، ومن ضمن الأدوات الاساسية للبنية الداخلية هناك العنصر البشري للحركة، تربيته، تكوينه الفكري، مشربه الدعوي، تعبئته النضالية، علاقته بالمجتمع بعدا او قربا، أو بالمفهوم الحركي الحديث اختلاطا او انعزالا.
القبعة الثانية هي تلك التي تعني الرميد بصفته من مؤسسي تجربة حزب العدالة والتنمية وأحد أهم المؤثرين في مسيرة الحزب وقراراته وتحولاته السياسية والتنظيمية، بما عرفه هذا الحزب من نجاحات وبما اعتور مسيرته من إخفاقات وخيبات للأمل لمناضليه وللمتعاطفين معه ولناخبيه ولعموم المغاربة حين تصدى العدالة والتنمية للتسيير الحكومي، وهنا أيضا نسب الرميد لنفسه كل البطولات (النجاح التنظيمي والسياسي والعلاقة مع القصر والعلاقة مع باقي أطراف المشهد السياسي وحل المشاكل التي يقع فيها الحزب وفض الاشتباك بينه وبين هصومه السياسيين خاصة في فترة ما يعرف بالبلوكاج فضلا عن رفض التطبيع …) في الوقت الذي نسب فيه بالتصريح أحيانا وبالتلميح أحيانا أخرى كل الخطايا والإخفاقات لإخوانه من قيادات الحزب، والحال أنه كان مسؤولا تمام المسؤولية مثل باقي قيادات الحزب عن كل المسلكيات التي طبعت التجربة السياسية لبنكيران ورفاقه، والمواقف التي يعلنها اليوم بخصوص المشاكل والمشاورات الداخلية والأزمات مع الدولة ومع فرقاء المشهد السياسي والانتخابي والتطبيع جاءت متأخرة جدا، ولو أعلنها في حينها لربما كانت أثرت في العديد من التوجهات، لكنها اليوم لا تعدو أن تكون مجرد توثيق تاريخي لمواقف كانت مجرد “حديث نفس” و “خواطر” لم يمتلك صاحبها الجرأة على التعبير عنها في حينها، ولذلك فهي تتخذ اليوم طابع الانطباعات النفسية على انقضاء زمن مضى بأماسيه وكراسيه.
ثم إن التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية لم تكن في المحصلة سوى استجابة لتحديات مرحلة 2011 التي كان لا بد فيها للبلاد من “بارشوك” تتقي به الدولة صدمة الفوران الشعبي الذي رافق موجة ما سمي بالربيع العربي، فكان الحزب هو البارشوك الذي تولى دور الواقي من الصدمات، أما الهيكل الذي يحمل هذا البارشوك فهو الدولة التي عرفت بفضل تراكم تجربة المخزن التاريخية كيف تتجاوز المرحلة بدون خسائر تقريبا، واتخذت قرارات جريئة كان أهمها اعتماد إصلاح دستوري متقدم عن سابقيه، واختيار شركاء سياسيبن جدد هم الإسلاميون هذه المرة، وانتهاج سياسة انفتاح واسعة توجت بالإفراج عن بعض المعتقلين وتوسيع هوامش حرية التعبير ولو بشكل مؤقت، وفي كل هذا لم بكن لحزب بنكيران ومعه الرميد أي دور، بل إنهم اختاروا لعب دور “البارشوك” وبرعوا فيه، وكأي “بارشوك” متهالك، انتهى الحال بالبي جي دي إلى مطرح المتلاشيات “لافيراي”، هذا إن لم نستعمل تعبير الصحفي الراحل الكبير خالد الجامعي حينما وصف تجربة الحزب إبانها بكونها مجرد “كلينيكس” الذي يرمى فورا بعد أن تمسح به الأوساخ.
أما ثالث القبعات فتتعلق بالرميد كرجل دولة مارس السياسة في أعلى مستوياتها وزيرا في قطاعات معقدة للغاية، تحدث عنها بأسوأ ما فيها وهو موقفه من حراك الريف الذي تبنى فيه الرواية الرسمية بشكل كامل، وهو الذي من المفروض أن ينحاز كليا أو لنقل جزئيا ونترك له هامشا للمناورة، أن ينحاز إلى مواقف ورؤى الجماهير الشعبية، إن لم يكن بصفته الحزبية، فبصفته الحقوقية، وفي حزبه الكثير من المناضلين من أبناء الشعب ومن ضحايا دغدغة العواطف التي تمارسها القيادات، ولحزبه أدبيات واضحة يعبر فيها عن انحياز كامل للقوى الشعبية، ولمطالب هذه القوى وتطلعاتها، وقد رافق الرميد في تجربته الحقوقية المتواضعة مناضلون بمواقف لا تختلف عن المواقف الوطنية الشعبية الشجاعة المعروفة عن القوى والشخصيات الوطنية التي تملك رؤية وطنية متوازنة تتبنى شعارات ترعى فيها في عمقها حقوق وواجبات كل من الدولة والمجتمع على حد سواء.
الرميد قال طبعا أشياء كثيرة، ولم يقل أشياء أخرى كثيرة أيضا، فقد ظل واجب التحفظ يصاحبه في كل مرة، وهو في هذا لم بغرد خارج السرب، ففي بلادنا يخرج أغلب المسؤولين من مهامهم “سارطين لساناتهم”، إلا أن أخطر ما تعرض له في حديثه هو ظروف زيارة بومبيدو للمغرب، التي ألغي فيها حفل عشاء رسمي كان مقررا احتفالا بالضبف، وأعطيت خلالها تعليمات للعثماني وبوريطة والرميد بلقاء المسؤول الأمريكي دون التطرق معه لقضيتي الصحراء المغربية وفلسطبن، والسبب حسب الرميد هو أن لا يتم الجمع بين القضيتين، وفي الخلفية أنباء عن وجود رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو في لشبونة منتظرا الضوء الأخضر للالتحاق ببومبيدو، الرميد لم يؤكد تأهب نتنياهو فعليا لزيارة المغرب، لكنه قال إنه اطلع على الخبر في قناة صهيونية، وليلتها لم يذق طعم النوم، والحاصل أن نتنياهو لم يزر المغرب، أو لم بسمح له، لا نعرف بالتحديد، وبومبيدو عاد بخفي حنين وبات لبلته بدون عشاء “رسمي”، أما الأخطر فهو ما حدث بعدها من أحداث في معبر الگرگرات أشار إليها الرميد دون أن يجزم بكونها مرتبطة بالمواقف المغربية التي رافقت زيارة بومبيدو، وما إذا كانت هذه الأحداث قد استعملت ورقة ضغط من أجل دفع المغرب إلى التسليم الكامل بشروط اتفاقات ابراهام.
ومهما يكن، فلا يمكن إغفال أهمية مثل هذه الحوارات في تحريك الراكد من النقاش الوطني، فالرميد اتفقت أو اختلفت معه يبقى واحدا من صناع جزء من التاريخ المغربي في العشرين سنة الأخيرة على الخصوص، وردود الفعل الكثيرة والمتباينة حول تصريحاته عامل إيجابي يجب أن يدفع الفاعلين السياسيين إسلاميين كانوا أم غيرهم إلى الخروج من صمتهم والإفصاح ولو عن نزر يسير من تاريخ نعايشه ولا نعيشه بمنطق الفاعل لا المفعول.