عبد ربه وفردوس الذكاء الاصطناعي
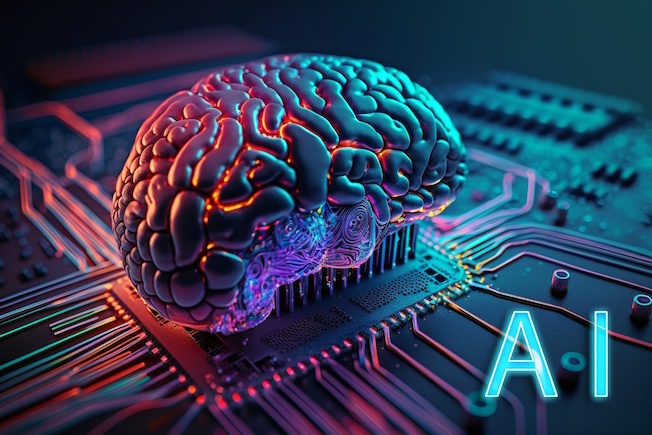
كان عبد الصمد يميل عادةً إلى تقليل عدد السجائر التي يدخنها بناءً على نصائح طبيبه، و لكن عشية هذا اليوم الحار من شهر أغسطس، حيث كانت الحرارة تقترب من 46 درجة، وتعطل المكيف، لم يجد عبد الصمد بديلاً سوى اللجوء إلى السجائر لتخفيف وطأة الحر.
أشعل عبد الصمد، الذي كنت أناديه ممازحا “عبد ربه”، سيجارته الشقراء العاشرة في غضون ساعة واحدة فقط من جلوسي معه، واستمر في التدخين بنهم، متحديًا حرارة أغسطس. و كان كل ما بناه في الأسابيع الأخيرة، من حمية غذائية صارمة وصوم متقطع لعدة ساعات، وتدخين ثلاث سجائر فقط للترفيه، قد انهار تحت وطأة هذا اليوم الحار.
حدق إليّ عبد ربه بعينين ناعستين نصف مغلقتين، وكأنه يستعد لإلقاء حكمة عميقة، ثم قال بتلك النبرة التي توحي أنه على وشك كشف سر خطير: “أنت لا تزورنا إلا نادرًا، مرة في الشهر فقط، لكن مرورك لطيف، قمر 14، بهي وسريع. شرفتنا بزيارتك الطيبة يا حبيب الله.”ابتسمت ابتسامة عريضة، وواصلت النظر إلى عبد ربه، الذي كان لا يزال يدخن كالمجنون وينفث دخان سيجارته الثانية عشرة في الهواء، مكونًا سحابة ضبابية في سقف الغرفة، سحابة ذكرتني برواية “الغثيان” لجون بول سارتر، رغم أنه لا توجد علاقة منطقية بين هذا وذاك.لكن، سبحان الله !صحيح أن السجائر والفلسفة الوجودية لا صلة بينهما، إلا أن الغرفة باتت تشبه عالم سارتر العبثي، حيث تتداخل الأشياء والجمادات والأفكار، وتتشابك المعاني والمباني في فوضى خلاقة.

عبد ربه ابتسامة خفيفة، تلك الابتسامة التي تحمل في طياتها شيئًا من السخرية، وقال لي وكأنه يبوح بسر خفي: “البشر؟ لا فائدة منهم. تخيل أنني قضيت سنوات أطلب العون من زملائي. أردت فقط بعض النصائح، ربما بعض البرامج التي تسهل علي عملي كمصمم إعلانات. لكن الكلب سيظل كلبًا… لا حياة لمن تنادي.”ثم تابع حديثه المضمخ بالأسى، وكأنه يلقي خطبة الوداع: “كنت أظن أن هناك تضامنًا بين زملاء المهنة، وأن البشر قد يكونون عونًا لبعضهم البعض. لكن الواقع شيء مختلف تمامًا.
فكل واحد منهم غارق في بحر أنانيته. لا أحد يسمعك، ولا أحد يمد لك يد العون.”انتقلت مرارة عبد ربه إليّ، وأحسست بوخز الدبابيس في قلبي. يا للألم! عالم من اللامبالاة والجحود. أشباه بني آدم. لسان حال كل واحد منهم يصيح: “أنا ومن بعدي الطوفان.” بؤس ما بعده بؤس.
ظللت أصغي لعبد ربه وهو منخرط في حديثه الذي يقطر حنقًا وألمًا، لكن تحولا مفاجئًا في نبرة صوته كشف لي أن الأسى لم يعد شعاره الوحيد.لقد كان هناك شيء آخر، شيء أشبه بالانتصار البارد يقفز من صوته، وكان عبد ربه قد وجد الحكمة أخيرًا في صخب العالم وقبحه اللامتناهي.”لكن…”ها هو ذا ينفث الدخان مرة أخرى، وكأن السحابة فوقنا تتضخم مع كل كلمة. “وجدت صديقًا جديدًا، أقوى من البشر وأذكى.”التفت نحوه باستغراب، فهذا الكلام لا ينسجم بتاتًا مع شخصية عبد ربه، فهو رجل عرفناه وعاشرناه منذ عقد ونيف، وما عهدنا فيه إلا الميل إلى الوحدة والحذر والانطواء على النفس كانسان لا يؤمن إلا بما تصنعه يداه.
حدجته بنظرة قوية وسألته: “لديك صديق جديد لا أعرفه؟”انفجر عبد ربه ضاحكًا، وكأن جدران الغرفة ستنهار من ضحكته المجلجلة، ثم اعتدل في ضحكه وقال:”لعلمك… صديقي الجديد ليس من لحم ودم، بل هو مجموعة خوارزميات وأكواد وبرامج. صديقي الجديد والحميم هو الذكاء الاصطناعي التوليدي.
“هنا، بدأت أفهم. هذا ليس صديقًا من ذلك النوع الذي نجلس معه في المقاهي أو نتبادل معه الأحاديث التافهة. هذا صديق مختلف، أقرب إلى الجني الرقمي. لم يكن يتحدث عن إنسان، بل عن تلك الكيانات الجديدة والروبوتات الرائعة الخدومة التي باتت تسيطر على حياتنا بذكائها الاصطناعي.
تابع عبد ربه بحماسة لم أعهدها فيه منذ فترة طويلة: “هذا الصديق لا يبخل عليّ بشيء. في اللحظة التي تخلى فيها البشر عني، كان الذكاء الاصطناعي هناك. يرسم لي المخططات، يعطيني الأفكار. يفتح لي أبوابًا كنت أظنها موصدة إلى الأبد.”
نظرت إلى صديقي عبد ربه بقدر لا بأس به من الدهشة والارتباك.كيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تكون البديل الأمثل للبشر؟وكان عبد ربه متسلطنا غارقًا في نشوته: “تخيل… العمل الذي كنت أنجزه في عشر ساعات، الآن وبفضل أدوات الذكاء الاصطناعي صرت أنجزه في دقائق. الملصقات الإعلانية؟ أصبحت أخرجها بجودة عالية وسرعة خيالية.
إنه صديق لا يمل، لا يتأفف، ولا يحتاج إلى استراحة.”كان يتحدث عن صديقه العظيم وكأنه اكتشف منجمًا من الذهب، وكأن هذا الذكاء الاصطناعي قد منحه مفاتيح العالم. ولم يتوقف عند مثال الملصقات الإعلانية. واصل عبد ربه حديثه وكأنه يروي حكاية خرافية:”لقد تعلمت حتى تصميم المواقع الإلكترونية، خطوة بخطوة، من الألف إلى الياء، وكل ذلك بفضل هذا الصديق المخلص.”شعرت أنني أعيش في رواية خيالية، وأن عبد ربه قد أصبح بطلًا في عالم جديد.
كنت أراه يحكي عن الذكاء الاصطناعي وكأنه يتحدث عن مخلوق خارق للطبيعة، قادر على إنجاز كل شيء دون تعب أو شكوى.”وماذا عن أصدقائك القدامى؟ البشر، أعني؟ أرجو أن لا تنسيك الروبوتات صداقتنا على الأقل!” هكذا سألته ساخراً وأنا أحاول العودة به إلى شاطئ الواقع.هزّ عبد ربه كتفيه باستخفاف، وكأن السؤال كان ساذجًا. “أصدقائي؟ لو كان فيهم خير، لما اضطررت إلى البحث عن بديل. لكن ما هي الحقيقة؟ لا أحد منهم يفيدني كما يفيدني هذا الذكاء الاصطناعي. إنه دائمًا هنا، يساعدني في كل شيء، دون تذمر أو ملل.”وفي تلك اللحظة، أدركت أن عبد ربه لم يعد يرى البشر بنفس العين التي كان ينظر إليهم بها سابقًا. لقد اكتشف عالمًا جديدًا، عالمًا خاليًا من التعقيدات البشرية، ومليئًا بالعمل المتواصل والكد والجد والحلول الرقمية السريعة.
وفي اللحظة التي انتهى فيها من تدخين سيجارته الثالثة عشرة، كانت الساعة تشير إلى السابعة وخمس وأربعين دقيقة، ونهض عبد ربه وكأنه أنهى فصلًا من حياته، وقال لي وكأنه يختتم عرضه المسرحي: “في النهاية، يا صديقي، البشر خذلوني. لكن الذكاء الاصطناعي أكثر رجولة وتعاطفًا من ملايين البشر. لا يكسر قلبي بالشكوى، ولا يتعب، ولا يخذل، ويجد لي في كل حين الحلول لكل المشاكل… ومن المؤكد أن هذا بالضبط ما احتاجه.”و عند تمام الساعة الثامنة مساءً، شعرت بالجوع يقرص معدتي، فاستأذنت عبد ربه في الانصراف.
تعانقنا بحرارة على أمل اللقاء بعد شهر أو شهرين، حسب الظروف والأحوال. وغادرت تاركًا إياه في الغرفة التي جمعتنا، وسط السحابة السريالية التي ما زالت تحوم فوقنا، وكنت صراحة أفكر في العالم الذي بات يسكن كل حواس وذرات عبد ربه.ولحسن الحظ، انضممت إلى نادي الذكاء الاصطناعي بتشجيع وإلهام من عبد ربه، واستمتعت بنعيمه ونعمه وجنيت منه ما لا يُعدّ ويُحصى من عظيم الفوائد.ذكاء… واصطناعي… يا سلام!إنه عالم يبدو فيه الصديق المثالي دون لحم ودم، إنه عالم من الأكواد والبرامج والخوارزميات، إنه عالم مدهش تتحول فيه الصداقة إلى عطاء وتعلم بلا حدود.إنه عالم غريب و عجيب، ربما نحن جميعا مجبرون على ولوجه و الاستفادة منه، سواء احببنا ذلك ام لا.





