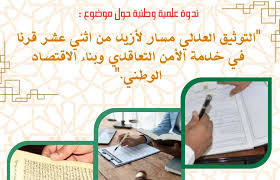الكمال لله

بيت واسع وفسيح تخترق جدرانه شقوق الزمن. هنا تتساكن التفاصيل الصغيرة، وتتصاعد أصوات الحياة اليومية. هنا الأمل والألم، الأفراح والأتراح، وذهاب وإياب لا ينقطع بين دمعة وابتسامة، وسلام مستتب وشجارات تمزق عنان السماء.

عادي جدًا… إنها سنة الحياة.
أمام الأم، وقف الأب كعادته يشير بإصبعه إلى الصحون المصفوفة بشكل عشوائي. بدا كأنه يكتشف نظرية فيزيائية جديدة وهو يقول:
“لماذا الصحون لم تُغسل جيدًا؟ انظري! بقايا الطعام كأنها شاهد عيان على مخلفات الحرب! ولماذا وضعتِ الكؤوس هنا؟ ألا تعرفين أن هذا المكان مخصص للأطباق؟”.
أعطى سيد البيت ملاحظاته. وفي الليل، والناس نيام، زلزل شخيره أرجاء البيت. وربما كان ذلك الصوت المزعج الذي يرجّ البيت كل ليلة كأنه إعلان عن نهاية سلمية للحرب. ولكن على لسان الأب كانت الأمور تؤول دومًا بشكل مختلف:
“شخير؟ هذا ليس شخيرًا، هذا مجرد تنفس عميق، لكنكِ تضخّمين الأمور كعادتكِ!”
أما الأم، فكانت تفضل دائمًا ألا ترد. كانت تركن إلى الصمت وتلتف حول ما يحدث، تمامًا كما يفضل الماء الالتفاف حول الحجر دون الاصطدام به. لقد اعتادت هذا اليم الهادر من النقار اليومي، وكانت تعلم أن مواجهة هذا الرجل أشبه بمحاولة إيقاف زلزال بقفازات مطاطية.
في زاوية الغرفة، كان علي، ابن السبع سنوات، يراقب المشهد بعيني طفل يحاول فهم عالم الكبار. سأل نفسه بصوت خافت:
“كيف لأمي أن تصبر على هذا الرجل؟ أليس للصبر حدود؟”.
أما خديجة، ذات العشر سنوات، التي بدأت تفهم الحياة عبر شاشة التلفاز، فقد كان ذهنها منشغلاً بمقارنة مشهد النقار اليومي للأب بمشاهد الأفلام الرومانسية التي تنتهي دوماً بالقبلات والأحضان تحت المطر. وفي إحدى تلك اللحظات، تمتمت في سرّها:
“لعنة الله على الزواج! كله نكد!”
لكن خديجة لم تكتفِ بالتمتمة. ففي مساء من أمسيات الشتاء الباردة، اقتربت من والدتها وقالت بصوت هامس:
“أمي، لماذا تصبرين عليه؟”.
كانت الأم تقلب الطاجين على النار و تتفقد الملح كأنها تتأكد من أن نصيبها في هذه الحياة لم يكن مالحًا جدًا. وبعد أن نضج الطعام، أطفأت الموقد وأجابت بحزم:
“لا تتحدثي عن أبيكِ هكذا، إنه والدكِ رغم كل شيء”.
“لكنّه دائم الشكوى، لا يعجبه شيء”.
ابتسمت الأم ابتسامة عريضة، لكنها حملت شيئًا من الانكسار، وقالت:
“يا خديجة، أغلب الرجال هكذا. بل لعل أباكِ أفضلهم. إن كرهتُ منه طبعه هذا، فقد أحببت صدقه وكرمه. الزواج يا ابنتي ليس كما تظنين. إنه ليس العناق والقبلات التي تشاهدينها في الأفلام. الزواج هو التراحم والصبر والرضا بالنصيب. كلٌ منا له عيوبه، ولكن الحياة تظل ناقصة، فالكمال لله وحده”.
في شرفة البيت المحاذية للمطبخ، كان الأب جالسًا يلتقط أنفاسه بعد يوم عمل طويل وشاق، و كان يحدق في كأس الشاي أمامه. ربما بدا قاسيًا متجهم الوجه وصعب المزاج، لكنه في داخله كان يعشق هذه الأسرة. حاول أن يتحدث عن مشاعره أكثر من مرة، لكنه كان يشعر أن الكلمات مثل الطيور، كلما حاول أن يُمسك بها فرّت بعيدًا.
“يا الله، كيف أشرح لهم أن ملاحظاتي الدقيقة ليست إلا ترجمة لخوفي عليهم؟ كيف يفهمون أنني أحبهم حتى عندما أرفع صوتي؟”.
في تلك اللحظة، تذكر قوله تعالى: “المالُ والبَنونَ زِينَةُ الحَياةِ الدُّنْيا” ، وشعر أن أبناءه هم زينته الحقيقية، رغم أنهم ينظرون إليه أحيانًا كأنه وحش كاسر.
ومضت الأيام. واصل الأب دوره الكلاسيكي كالناقد الأول في البيت، وصبرت الأم كأنها جبل أسطوري يتحدى أعتى الزوابع. بدأت خديجة تفهم أن الحياة ليست فيلمًا تركيًا، وأن الزواج ليس حفلة راقصة على أنغام الموسيقى.
وذات يوم، قال الأب، بينما كانت الأسرة تتحلق حول مائدة العشاء:
“أتدرون؟ ربما لا أقول هذا كثيرًا، لكنني فخور بكم جميعًا. أنتم سر حياتي”.
نظر الجميع إليه بدهشة، حتى خديجة التي بدأت تشعر لأول مرة أن والدها ليس مجرد “نقّار مزعج”. هنا ارتسمت على وجه الأم ابتسامة هادئة، وتنهدت بارتياح متذكرة قوله تعالى: “وَجَعَلْنَا بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”.
في تلك اللحظة، شعر علي أن والده ليس سيئًا كما يظن، وقررت خديجة أن تضيف هذه اللحظة إلى قائمة الأشياء التي قد تجعل الزواج أقل لعنة مما كانت تعتقد.
و في عيد ميلادها الثالث والثلاثين، بعد أن أصبحت روائية عالمية ذائعة الصيت، كتبت خديجة خاتمة روايتها الموسومة “الكمال لله” :
” ومع ذلك، يبقى بيتنا مثل نهرٍ لا يتوقف عن الجريان. تتغير ملامحه مع الزمن، تتآكل حوافه، لكنه يستمر في احتضان الحياة. لم يكن بيتنا مثاليًا، لكنه كان حقيقيًا. كان صخب أبي وهدوء أمي وجهين لعملة واحدة: الحب الذي لا يظهر دائمًا في صورة عناق أو كلمات لطيفة، ولكنه يتجلى في أدق التفاصيل اليومية، في نقاشات المطبخ، وفي صوت أطباق تُغسل على عجل، وفي نظرة عابرة بينهما حين يظن كلاهما أن لا أحد يراقب الآخر.
واليوم، وأنا أجلس في مكتبي وأتذكر كل تلك التفاصيل الصغيرة التي شكّلت حياتي، أضحك على سخافة أفكاري في العاشرة من عمري. لم يكن الزواج لعنة، ولم يكن الكمال أبدًا الهدف.
كان الزواج رحلة، مثل كل شيء آخر في الحياة، مليئًا بالمنحدرات الحادة، لكنه دائمًا كان رحلة تستحق العناء. لقد تعلمت من أبي أن الصرامة ليست دائمًا قسوة، وأن هناك حبًا مختبئًا في ملاحظاته الدقيقة التي كنت أراها يومًا ما ضربًا من النقد الجارح.
وتعلمت من أمي أن الصبر ليس ضعفًا، بل قوة تقود السفينة وسط العواصف دون أن تغرق. وأنا أكتب هذه الكلمات اليوم، لا أفكر في أبي وأمي فقط كأبوين، بل كأبطال لقصة استثنائية علّمتني أن السعادة ليست غاية، بل هي لحظات صغيرة مبعثرة، علينا أن نلتقطها بعناية، مثلما نلتقط الزهور البرية من سفح الجبل.
واليوم، أتمنى لو كنت أستطيع العودة إلى تلك الأمسيات الشتوية حين كنا نجلس جميعًا حول مائدة الطعام، وأقول لأبي وأمي: ‘لقد كنتما ولا زلتما أعظم أساتذتي. لم تكونا كاملين، لكنكما كنتما حقيقيين، وهذا هو المهم.. إن الكمال لله وحده، والحياة – مثل الكتابة – مليئة بالفوضى والتناقضات.
ولكن هذه الفوضى هي ما يجعلها حقيقية، جميلة، وساحرة في الوقت نفسه.”