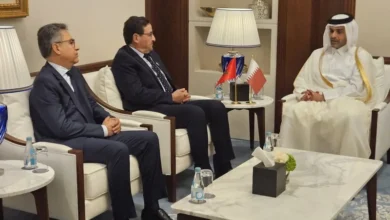عبد الكريم برشيد بين إبداعية النقد ولعبة الفرجة الدرامية
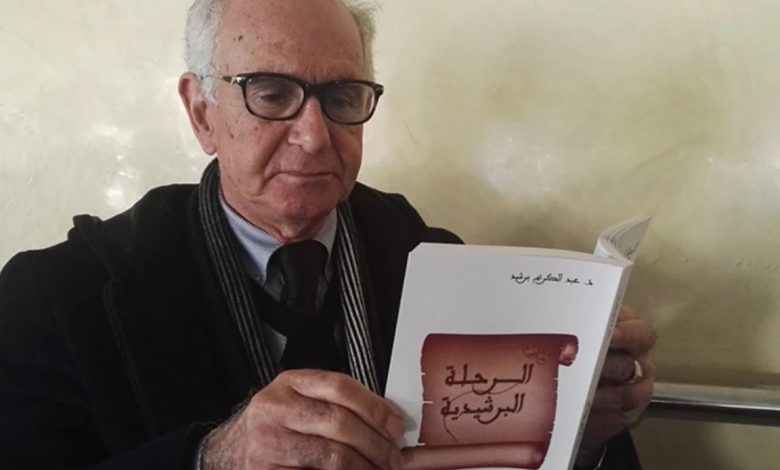
بقلم:د.الغزيوي بوعلي
إن العودة إلى مسار الحركة تكشف عن وصول متأخر للنص، وذلك لكونه واحدا من العناصر المتأخرة التي انضافت إلى هذا الفن، لأن العتبة العليا التي يلتقي حولها النقاد والباحثون للبحث عن استقلالية للمسرح تصطدم في المرة الأولى بالنص الذي يعتبر الوثيقة الأولى عبرها يتم بناء رؤية المؤلف وعالمه(1)، وهذا النقل للنص يسجل فيه المبادئ الهامة التي توجه كتاباته، لأن العلاقة التي تحكم بين الأدب واللغة من وجهة نظره، هي عبارة عن مبادئ يتكرر بروزها بشكل ضمني في كثير من الأعمال السائدة والماضية، وليعبر عنها بطرق متنوعة، لأنها الأساس الذي يقيم عليه في الوقت ذاته، ويرى أن العرض ليس إلا تعبيرا أو ترجمة للنص الأدبي، وتنحصر مهمة المخرج في أن يترجم إلى لغة أخرى، نصا يجب عليه أن يبقى أمينا له ومفسرا له(2)، هذا التمسك الحرفي يجعل المخرج والممثل والجمهور أسير الدلالة ووفق أغر اض نفسية وأهداف عملية، في حين أن النصوص المفتوحة تحمل تأويلات عدة، التي ليست مفروضة من طرف الجمهور، ولكنها ناتجة عن التفاعل بين النص وبينه، أي ما يسميه إيكو بالتشارك النصي.
فالنص بما يحمله من كلمات وجمل وأفكار ومشاعر وخيال وإحساس، لا يمكن حصره، بل تركه يتحول إلى مغامرة تأويلية حرة حسب تعبير “إيكو”. إذن كيف يراقب المؤلف مشاركة القارئ أو الجمهور؟ وكيف يمكن للنص أن يكون حقلا للمشاركة وللتفاعل؟ وكيف يتفاعل عبد الكريم مع المسرح؟
ينهج عبد الكريم برشيد استراتيجية تعادل استراتيجية المحارب، فهو يريد للنص أن لا يكون عدو القارئ ولا يريد أن يفقده، ويقول تیروفTairov” “: “إننا لا نعتقد أبدا في أن مهمتنا تنحصر في تأويل العمل الأدبي أو في أن مهمة المسرح ودوره هو خدمة العمل الأدبي، كما أن وظيفتها لا تتلخص فقط في لعب هذا العمل فوق الخشبة، إن الأمر على العكس من ذلك، فعندما نتناول عملا أدبيا، فإننا نكون تماما أحرارا للبحث فيه بهدف خلق عمل جديد يسمى عرضا، إن لدينا من الحرية ما يكفي لنستخلص منه كل ما هو ضروري بالنسبة لعملنا، ونشكل منه بالتالي عملا مسرحيا جديدا”(3). فالناقد والمؤلف قطبان يتصارعان بشكل ضمني ويستهدف أحدهما الآخر، لأن النص مسرح هذا الصراع؛ أي أن هذا الصراع ينكتب على امتداد النص ليصبح كل من المؤلف والقارئ النموذجي استراتيجيتين نصيتين”(4). فالمؤلف ينهج استراتيجية للانتصار على الناقد وعلى الجمهور، انتصار المؤلف رهين بمدى بنائه لقارئ ناقد مشابه للقارئ الحقيقي حيث بإمكانه أن يتعاون من أجل تحقيق النص بالطريقة التي يمكن أن يتحرك النص تأويليا وتمسرحيا. فالمؤلف يتحرك توليديا بخلقه لنص مبهم وغامض (Ambigue) أي بخلقه لنسیج من البياضات والفراغات، وفي المقابل يتحرك الناقد تأويليا، حين يعمل على فك ألغاز النص عن طريق ملئه لتلك الثغرات والثقب. ويقول “إيكو”: “إن النص إنتاج يجب أن يكون مصير تأويله جزءا من آلياته Mécanisme التوليدية”(5). من هنا فالناقد لا يكتفي بالأمل في وجود النص، ولكنه يتحرك ببصره انطلاقا من عملية التمسرح، لذا يصبح الغرض جدولا من الإمكانات المحددة بعناية والمشروطة بطريقة يصبح معها رد الفعل التأويلي قادرا على الانفلات من سلطة المؤلف كما يرددها عبد الكريم برشيد.
– النص باعتباره مشروعا جوهريا :
إن النص ليس عبارة عن نظام قائم بذاته، ولكنه سيرورة التلاقي تجمع بين الممثل بالجمهور والممثل بالمخرج، والمؤلف بالناقد، فهو يساهم في تلوين وتهييء هذه السيرورة الزمنية التي تظهر في نوعين أساسين :الاسترجاعات والاستباقات، في النوع الأول تروى الأحداث بعد وقوعها، وفي الثاني قبل وقوعها، ونتيجة لذلك فالناقد المسرحي يتناول المفارقة الزمنية التي تتجلى في المسافة الفاصلة بين لحظتي تخي يل وتمسرح، فضلا عن اتساعها Amplitudeالذي ينعت بداخلي وخارجي وفق تقاطع الزمنية والعرض الرئيسي، وزيادة على هذا فالناقد يوظف الحذف Ellipse والمشهد Scène والمجمل Sommaire من وجهة نظر الديمومة Duree لمقارنة زمن النص بزمن العرض بشكل متواتر Fréquence، مما يخلق ثلاث إمكانيات:
1- العرض الواحدي Simgulatif.
2- العرض التكراري Répétitif.
3- العرض الإبداعي Créatif.
وعبر هذه الوحدات تخلق المواجهة مع الذات والآخر، لأن المسرح حسب برشيد يلاقي بين كل العناصر في شكل كتابة قوية قائمة تقف بجانب الكلام، لأنها رمزية وتجه من نحو الداخل، تقول “إلياس” “كيف أعرف ما أفكر فيه قبل أن أرى ما أقوله؟
فالكتابة تنمو مثلما تنمو البذرة، وليس مثلما ينمو السطر”(6) فالنص إذن معد للاحتراق théâtre à bruler اللحظوي، وسرعان ما ينطفي بسرعة ويتهدم بعده الحراري يقول داريف Dariofo”: “فإنني أحيانا أهدم نصوصي أو بتعبير أوضح أعيد كتابتها مرة أخرى حتى تتلاءم مع حقيقة أو معنى آخر”(7)، من هنا نتساءل هل يهدم الناقد ما بناه المخرج والمؤلف؟ وهل يمارس نوعا من الكتابة المتعدية؟ أسئلة تتعلق بالعملية التأويلية التي بموجبها توقيع عقد الاختلاف بين المؤلف والناقد وبين النص والعرض، وقد بدأت تظهر بوادر مشجعة على الصعيدين (النص والعرض( فعلى صعيد النص شهدت الساحة العربية كما قلنا نقاشا حول قضايا حقوق المؤلف لم يسبق لها مثيل في تاريخها، وقد شمل مواضيع مثل نظام النص وحقوق المؤلف والعلاقات مع المخرج والمؤسسات الغير الحكومية، وأما على صعيد العرض فإن النص لا يشكل إلا بذرة بجانب البذور الأخرى التي تساهم في بلورة رؤية مسرحية تعكس الوعي الإبداعي المضاعف ويقول “عبد الكريم برشيد” في هذا الصدد: “النص المسرحي هو بالتأكيد، ليس مسرحية وإنما هو مشروع مسرحية أو مسرحيات متعددة، فالشيء في الاحتفالية لا ينظر إليه في سكونيته ولكن في حركيته. وبهذا فالمسرحية ليست هي النص، ولكن ما يمكن أن يصير إليه هذا النص، فالنص لا يعطيك إلا يقدر ما تعطيه من جهد وبحث، فهو يضيق ويتسع، يتمط ط ويتقلص ويبقى أن حقیقته النهائية في فعل أو أفعال، وليست حالة أو صورة معينة، فالنص بداية للفعل المسرحي وليس نهاية له”(8)، و”برشيد” ينفي أن يكون النص سببا في غياب العملية التمسرحية، وذلك لأن النص يظل من خلال حركيته وحيويته نصا أدبيا ومسرحيا في نفس الوقت، لأنه يؤكد على تمسرح الخشبة دون أن يفقد أبعاده الأدبية، مادام يخضع للتفجير، أي للإخراج ما فيه من حيوية وحرارة وآنية”(9).
فالنص يرسم استراتيجيته اعتمادا على وسائل متعددة، منها اللغة والمعجم والأسلوب، والناقد يفكك هذه النماذج بمعايير فنية Technique وحرفية Artisanantes (المثابرة + الدقة + الإقناع) لجعل القراءة المضاعفة تتخذ بعدا وصفيا زمنيا وتاريخيا وصفيا، أي أن الممارسة النصية تولد من خلال بعدين، بعد زمني تأويلي وبعد لغوي. فالبعد الزمني التأويلي يتابع فيه الناقد العمل المدروس بوصفه تسلسلا زمنيا، أي في بعده الأفقي، والبعد اللغوي يحتاج إلى التوافق بين الألفاظ ودلالتها، وعلاقة بعضها ببعض منطقيا وتعارضيا من أجل الوصول إلى المعنى المضاعف، وهذا ما يمكن تسميته المستوى العمودي؛ إذ الناقد يزيد من الإشارة الزمنية والعلاقة المنطقية البعد التضاربي والتضادي الذي يسود بين عناصر الجذر الإيحائي.
– عبد الكريم برشيد والكتابة المسرحية :
يقول “إيكو” بأنه “ليس هناك شيء مفتوح أكثر من نص مغلق”(10)، ولكن انفتاح هذه النصوص البرشيدية ليس من داخلها، بل إنها عملية خارجية تأتي من جهة القارئ، من بنية النص، لذلك يذهب “إيكو” إلي أن هذه النصوص المغلقة “أقرب إلى العنف منها إلى التشارك”(11). فالحديث عن الانفتاح والانغلاق كان دائما وسيظل حديثا إشكاليا وغير مستقر داخل المجال الأدبي الدرامي من جهة، والخطاب الفلسفي والإنساني من جهة ثانية، لقد ظل المسرح في أحسن الأحوال صورة للعبة القلب والتحويل الممارس على الواقع من طرف المؤلف والمخرج. لذا اعتبر هذا الإغراء وعيا ملازما للذات المبدعة والناقدة، ووسيلة لتجديد نظرتنا لثقافتنا ولتاريخنا الذي لا يمكن أن نعيشه إلا بواسطة الخيال الاجتماعي حسب “بول ريكور”(12). إن وظيفة النقد المسرحي هو الذي يعمل على خلخلة الذاكرة الجماعية حتى تتحول القيمة التأسيسية للأحداث الأولية موضوعا لمعالجة والدرس، وينتج عن ذلك أن المؤسس ذاته لا يمكن أن يعاش من جديد وأن يخلد من طرف أفراد المجموعة الإنسانية إلا بواسطة تأويلات بعدية تعيد صياغته دائما… وهذا يعني أن الحدث المشيد من طرف الناقد العربي لا يقوى على تقديم ذاته مباشرة کوعي جذري، بل يبقى ربط فعل “التخليد الجماعي وبين الحدث المؤسس عبر التمثل الإيديولوجي، فكل مجموعة تظل قائمة وتؤمن من استمرارها ووجودها الفعلي بفعل الصورة الثابتة والدائمة التي تصنعها عن ذاتها وتتمثلها إيديولوجيا. إن هذه الصورة الثابتة هي التي تعبر عن المستوى الأكثر عمقا من مستويات الظاهرة الإيديولوجية السابقة”(13).
فإبراز مسار الإنتاج المسرحي العربي کفن مستحدث، جعلنا ندرك أن عبد الكريم برشيد المسرحي العربي يعمل دوما بالارتباط بالواقع والواقعية وبطموحاتها النظرية، وترابطها مع التصور الاستتيقي والإيديولوجي. ومن ثم ارتبط المسرح العربي بظاهرة تتمثل في ملاحقته للواقع المادي، وكل تغيير وأحداث سيعرفها المجتمع العربي ستنعكس على الواقع. لذا جاءت المسرحيات منقطعة عن جذورها الكلاسيكية، كما أن التقنيات تنوعت بدورها، إذ خرجت عن القيود الواقعية ومزجت بين الوصف والتذكر، وكذا المشاهد الحوارية تعددت وظيفتها الجديدة في سباق تأسيس خصوصيتها داخل شمولية الجنس الذي تنتمي إليه. والمسرحي جعل الذاكرة والاستذكار عبارة عن زمان نفسي مماثل وملتزم بالعالم الخارجي، ليعيد القضايا الاجتماعية بعدما تراجع التيار الوجودي والواقعي الذي ساد الخمسينيات والستينيات، وليطرح بدلا عنه رؤية تهتم بالهم القومي والصراع الطبقي والإنسان الجديد في الواقع الجديد، وهذا الارتباط بالطابع الواقعي العام هو الذي سيجعل المسرحي العربي يحلم، وأن يكون المؤرخ والسياسي للعلاقات الاجتماعية والمعرفية، ليبحث في ذواتنا عن مفتاح حركة التغيير. وبما أن المسرح ارتبط بالتقنيات والأساليب الأدبية والأبنية المسرحية ليست كغاية في ذاتها كالمعاني والمضامين، ولا يقتصر عليها لتحويل ما هو عرضة في الطريق أو خلف الواجهات، فالبحث في الأشكال هو بحث في الدلالة المحايثة له وملاحظة الواقع المادي، مما أدي بالمسرح العربي إلى أن يعرف ظاهرة تتمثل في شيوع ما يسمي بمسرح الحقبة كرواية الحقبة إن صح هذا التعبير، وهذا الإسقاط أي تلك التي تحاول أن تحاصر البطل والأحداث في حقبة سياسية معينة، لتصبح رهانا آخر وسط الاحتمالات وملحمة في كليتها التعبيرية المتقاطعة بين سردية النفسي والاجتماعي والسياسي، إذ الكتابة المسرحية المضاعفة هي النص الثالث، وهو “بمثابة التقسيم الفني للفيلم، وهو صورة مسرودة تنقل كل دقائق العرض المسرحي […] وأكاد أذهب إلى أن النص الثالث مهما يكن دقيقا ومفصلا، يظل مجرد مشروع لا يكتمل إلا مع العرض الحي، ومجرد اقتراح نظري يأخذ صورته النهائية مع كل عرض”(14). فالناقد برشيد في قراءته للنص أو لمشاهدته العرض، تأخذ أبعادا دينامية وحوارية في النص، لتشكل فضاء مفتوحا يعرض من زوایا متعارضة ومتساوقة حسب تغير العلائق والأحداث والعالم والأشياء، إنه فضاء متغير تنبع دلالته من خلال المغامرة التمسرحية، وارتیاد المجهول واللامعقول. لأن فبنية العرض تؤسس عمقا تناصيا وحوارا لمختلف النصوص التراثية لتدخل حوار مؤسلبا ومهجنا، هذا التنوع التأويلي المضاعف يسمح للناقد باستخلاص مجموعة من الأشكال والتأثيرات المتولدة عبر سياقات مختلفة.
إن الكتابة النقدية المتولدة هي عبارة عن لغة واصفة Meta-langage، تتعدد بتعدد الدلالة والإيديولوجية والجمالية للخطاب المسرحي، لأن هذه الملامح العامة للكاتب تسمح لنا بالقول بأن هناك نسقا عاما يؤطر استراتيجية الخطاب المسرحي العربي، هذا النسق يتجلى في دلالات التعدد وفي الإرشادات المسرحية والحوار، تعدد يتمظهر من خلال مستويات متداخلة تتفاعل تبعا لدينامية النص المسرحي وتموجاتهه. تقول “آن أوبر سفيلد”: “يتجلى أساسا في تعليق كلام الأنا بكلام الآخر”(15). فالنص إذن ليس عبارة عن كلمات تجري على الخشبة، وإنما كتابة جسدية وبلاغة رمزية تتجذر في هذا الفضاء عبر لغة دراماتيكية جمالية تنتقد الدلالة الحرفية التي تمجد سلطة المكان والزمان المطلقة، وتتأسس على الديكور والإنارة التي تجسد المناخ الذي تجري فيه الأحداث والوقائع والشخصيات وأيضا الأصوات والحركات، وكل المواصفات الكلية التي تلغي كل إمكانية الحديث عن الحوار الذاتي والمراقبة الاختيارية بتعبير “بيير زيما” لأن التفاعل بين النص وتوابعه بأخذ بعدا نقديا لكون المؤلف يمارس عملية الإبداع ويحاول أن يشارك الناقد أو القارئ في الإنتاجية النصية، وهي مشاكل بدأت تظهر على السطح وتتبلور في الكتابة المسرحية بعدما أن اجتازت هذه الأخيرة مراحل البحث عن الذات، وأصبح الوعي الآن بعملية الكتابة المسرحية أمرا واضحا انطلاقا من الهاجس الذي أصبح يشغل بال المسرحي العربي، هاجس تحقيق مسرحية تعبر عن واقع مفكك ومهزوز. إذن أصبحنا نعثر في المسرح العربي على خطابات میتاواقع تساءل عملية الكتابة ودرجاتها، للتفاعل مع ذاتها والخارج – النص – كما قلنا سابقا، هكذا أمست المناصية تمارس نقد الواقع، معلنة عدم اقتناعها بما يحكي، أو يسرد، أو يتكلم، هذه المساءلة وما تتبيح من إمكانية إثارة الأسئلة الهادفة أكثر من إعطاء المسكنات التي تهدأ الواقع الزيف، يقول “مارون النقاش”: “إن طلاوة الرواية ورونقها وبديع جمالها يتعلق ثلثه بحسن التأليف وثلثه ببراعة المشخصين، والثلث الأخير بالمحل اللائق والطواقم والكسومة الملائمة”(16).
– النقد بين الحوار والإرشادات المسرحية عند عبد الكريم برشيد:
إن النظر إلى الشكل الذي بطبع النقد المسرحي بالعالم العربي يجعلنا نحس بأنه يعكس أمامنا جملة من التراكمات القرائية والتأويلية التي تؤكد أن النقد ما هو إلا تعبير عن واقع اجتماعي وجمالي، اكتسبت معه صفات منفردة، وجعلت منه نصا موازیا برشيديا أكثر تعقيدا وليس مجرد محاولة سردية تحكي ما كان بسيطا، بل إنه تجريب يهدف إلى قياس الواقع في تنوعه وتعدده وغموضه، يرجع فيه المبدع إلى نفسه أو إلى ذاكرته ليؤول ما كان أو ما ينبغي أن يكون بلغة تنحى عن اجترار المألوف، سواء على المستوى الذهني أو التخييلي، لأن طغيان البعد الاجتماعي والجمالي، يعني انتشار الوعي بمشاكل الإنسان بكافة أبعاده الكونية، وهذا البعد التأويلي هو الذي يجعل أغلبية القراءات تنحو منحي القراءة الإيديولوجية، ويبقي النقد كلغة میتامسرح، حيث بواسطته تتم محاكمة النصوص المسرحية التقليدية التي تؤكد بوجود المسرح العربي، مع استبعاد عنصر التشويق لأن هذه المعاودة هي تحديد أزمة فقدان الثقة في الكتابة المسرحية بشكلها المعهود سابقا، والتي أصبحت عاجزة عن تفتيت الواقع وتثويره من الداخل؛ وبالتالي هذا العجز سيطال حتى رموز هذا الفن يقول “مارون النقاش”: “أما أنا فلا أستحسن هذه الإرشادات، بل إنما أنا على رأي موليير أشهر المؤلفين بهذا الفن الذي قال إن من لا يحسن تشخيص روايتي بدون إشارات تدل على ما ينبغي عمله، فالأحسن ألا يشخصها”(17). يبدو من خلال هذه المنظومة الفكرية بالإرشادات المسرحية، ازداد نموها مع بروز المخرجين في القرن التاسع عشر، لذا اختار “مارون النقاش” موقفا حداثيا يمنح للمخرج الحرية ويسمح له بالخرق؛ وهذا يعني أن النص يأخذ تركيبة بعيدة عن كل الإرشادات المسرحية التي تحاصر المخرج والممثل وتجعلهما تحت رحمته، وهذا ما نلمسه عند المخرجين أمثال “سليم البستاني” و”يعقوب صنوع” و”نجيب سرور” و”سعد الله ونوس” و”عز الدين المدني” و”علي الراعي” و”يوسف إدريس”. فهؤلاء فتحوا باب التأويل جاعلين النص مفتوحا وغير مختوم، لأن هذه التخريجات الفنية ميزت بين البعد الحواري والإرشادات المسرحية، وذلك انطلاقا من السؤال التالي: من يتكلم في الحوار ومن يتكلم داخل النص، إنه ذلك الكائن من ورق، حيث تجيب “آن أوبر سفيلد” إن هذا ما نسميه بالشخصية Le personnage، وهذه الشخصية تختلف عن المؤلف أو الكاتب. فالكاتب ينوجد في الإرشادات، وهو الذي يسمي الشخصيات ويعين من يتكلم في كل لحظة ويخصص لكل منها موقعا في الخطاب، وكذا في الكلام، ويعين الحرکات والإشارات بمعزل عن كل خطاب.
فهدف الناقد المسرحي عبد الكريم برشيد مزدوج، من جهة يبحث لمعرفة التواصل بين النص والعرض بمصطلحات لسانية وسيميولوجية ونفسية واجتماعية، ومن جهة أخرى يبحث عن المستوى الفرجوي الملغي القيمة المهيمنة حسب جاكبسون. فهذه الملامح العامة الجمالية والدرامية واللغوية والنفسية والسينوغرافية… تسمح لنا بالقول بأن هناك نسقا عاما يؤطر استراتيجية الخطاب النقدي. هذا النسق يظهر في شكل دلالات التعدد التأويلي من طرف الجمهور والقراء، لكن هذا المظهر التعددي لا يأخذ مجرى خطي، بل يتمظهر من خلال مستويات متداخلة تتمازج وظائفها وبنياتها تبعا لسنة التوظيف النقدي.. فالتمايز بين الحوار والإرشادات هو تمایز بين المؤلف والممثل، وبين المخرج والمؤلف، وبين المؤلف الناقد، وبين المؤلف والمجهور، تمايز لا يبرز لنا شخصية المؤلف من لحم ودم، بل تتدثر بلغة إيروسية ورمزية وأسطورية لتتخذ اسما غير اسمها الحقيقي. حيث إحساسات المؤلف تجسم وجهات نظر مختلفة ومتنوعة، وتعكس آراء متناقضة، وكل شخصية تنهض بوظيفة سردية وإيديولوجية وتعبر عن موقفها من العالم.
إذن هل يمكن الحديث عن النص المسرحي بدون إرشادات؟، فالإرشادات الموجودة في النصوص التي تبدو خالية منها مادام أنها قادرة على تحويلها إلى أنوية نصية، كما فعل صمويل بيكت في مسرحية “Acte sans parole” و”Oh les beaux jours”، فهذه الإرشادات كما قلنا تضم الشخصيات التي تقدم من وجهات نظر مختلفة، ولتعبر عن مواقف الدلالية والرمزية والانزياحية غير المفصولة عن السياق التعبيري والتركيبي، ولتتمظهر الأسئلة في شكل حوارات وإرشادات التي تجيب عن السؤالين الجوهريين: من؟ وأين؟، إنها تحول الكلام إلى الشروط المادية، أو إلى بعد برغماتي. تقول “آن أوبر سفيلد”: “إننا إذن نتبين كيف أن نصية الإرشادات المسرحية تفصح عن كل ما يمكن توظيفه من العناصر في العرض، ولم يذكر إلا باعتباره كلاما”(18). وتأسيسا على ما ذكر فإن الأشكال التي يستضيفها الخطاب النقدي البرشيدي المسرحي لا تسعى إلى خلق توظيف موازي يدخل في سياق ومنظور نقدي شامل، أي انتقاد بنية الخطاب المسرحي الكلاسيكي في تركيباته وسياقاته التراثية، وفي نفس الوقت انتقاد الدلالة الإيديولوجية التي تمجد النص كخطاب يتعارض مع الرؤية النقدية التي تمنح تعددا جوهريا وتتجاوز كل الإرشادات والصيغ الخطابية التي تقدم نفسها كخطاب واحد ووحيد، وتتحدد هويته من منظور مونولوجي تتضمن كل المواصفات التي تستعيد إمكانية الحديث عن الحوار النقدي والمراقبة التأويلية والاختيارية يقول “د. عبد الرحمن بن زيدان”: “ولما كان المسرح خطابا يعبر عن طبيعة العالم في نموه وسيرورته واستمراريته وتغيره، وانتقاله من مرحلة إلى أخرى على شكل قفزات وطفرات، وفي مسار حلزوني لا يكرر ما فات ولا يعيد ما ولى، أصبح من المحتم ألا يعترف هذا المسرح بهذا السكون والثبات السائد عند الكلاسيكيين والرومانسيين، لأن حالة التوتر والقلق بين الوجود والعدم تعيش داخل الصيرورة المنبثقة من التفاعل المستمر بين الكائن والمحتمل”(19). إذن نحن أمام بابين: باب النص الدرامي وباب النص النقدي وحوار بين مرجعيات تراثية وغربية معاصرة تتفاعل في شكل جدلي بين مختلف التوترات الجمالية والدرامية والتاريخية والتي تحاول أن تتخلص من صفتها كنصوص درامية، كما تسعى الأشكال النقدية أن تنزع عن نفسها غطاء المونولوج لتفتح مجال التأويل قصد تكوين رؤية نقدية من خلال قصدية جديدة. فالنص إذن يحتمل الحوار والإرشادات ويحتمل التأويل والنقد، إنه عبارة عن تناص يستوعب كل المظاهر الثقافية والجمالية والنقدية، وينتج التخيلات والمحكيات لكي يجسدها في ثقافة الجمهور، كل هذه الفواصل هي (الإرشادات، الحوار، …) أرضية نقدية تعمل على قلب الموازین المعيارية القديمة، وتخلخل المضامين الذاتية لتطرح أسئلة وقضايا جديدة مرتبطة بتطور المسرح والنقد من داخل بنيات التفاعل التي تنفي الرؤية الخطية. لذا يتحرر الإيحاء الدلالي والتركيبي والجمالي من معناها المعجمي إلى دوال دائمة البحث عن مدلولاتها. ومع كل هذا يكتسب النص مدلولا جديدا، وتتعدد التأويلات بتعدد القراءات. لأن هذه العملية هي التي تخصب التفاعل بين النص والقارئ (الناقد(، وتجعل النص يولد ولادة مستمرة في الزمن والمكان، يقول “رولان بارت”: “إن العمل القرائي عمل لغوي أن نقرأ معناه أن نوجد معان، وإیجاد المعاني يقتضي تسمیتها، لكن هذه المعاني المسماة، تندفع متجهة نحو أسماء أخرى … الأسماء تستدعي بعضها البعض، وتندمج وتتجمع، وهذا الاندماج محتاج دوما إلى أن يسمي نفسه أو يلغي هذه الهوية أو يعيد بناؤها، هكذا يسير النص … إنها تسمية في حالة صيرورة مقاربة غير مملة وعمل مجاوزي أساسي…”(20).
فعبد الكريم برشيد يرى النقد هو كتابة مضاعفة، تنطلق من فرضية تفكيك النص، وليس من نقله وهذا التفكيك هو عملية تحرير الحقيقة من الأسر، واللغة الدرامية من سلطة الكلام (المدلول( حسب مفهوم “جاك دريدا”، وتحرر الذات من عقدة امتلاك الحقيقة المطلقة لتتحول إلى ملتقى طرق، ولتلتقي باللغة وبالرمز والأسطورة والتاريخ وبالواقع… لذا فتكسير حصانة النص هو قتل للمؤلف حسب “بارت”، فالخطاب النقدي المسرحي يستوعب هذه المفاهيم، لأن التساؤل حول الأشكال التراثية يستدعي مختلف أساليب الكتابة، وإمكانية المحاورة والمعاودة. من هذا المنظور تتوخى هذه الملاحظات إثارة الفضول في الموضوع وإثارة الأسئلة كمؤشر لتوسيع دائرة التأصيل وتثوير حلقة الحوار حول هذا النموذج النقدي، انسجاما مع ذلك تطرح الأسئلة نفسها في أي حقل دراماتيكي يمكن تصنيف هذا الفعل؟ هل هناك نقد مسرحي عربي؟ وما علاقته بالنسق المرجعي السوسيوثقافي والهيرمينوطيقي؟ هل فعلا تملك تراكما نقديا بكل تجلياته وتمظهراته؟ أم أننا دوما نسقط في النزعة الميكانيكية والتعصبية؟ فهذه الأسئلة تبقى في النهاية مؤقتة ومحدودة، لأنها لا تتوفر على سلطة قاهرة تسمح بتنفيذ ما يعتقد به، وما يسنن القوانين وهذا القصور التراكمي لا يعني الغياب الكلي للنقد المسرحي، بل نجد مجموعة من النقاد مختلفي الاتجاهات والمدارس جعلوا منه (النقد) شجرة تتكلم بتناسل الفروع المعرفية، مما يؤدي إلى خلق إوالية انشطارية معاكسة ترافقها تحولات اجتماعية ورؤيوية التي تهدد العالم الخارجي. فظهور بعد المثاقفة جعل النقاد يواجهون القضايا التقليدية في المسرح حول أسبقية الوجود على الماهية والتعريب والغريب، غير أن هؤلاء “فاروق عبد القادر”، “عبد الرحمن بن زيدان”، “حسن المنيعي” و”عبد الرحمن ياغي”، قد أعطوا لهذه المشكلة وجهة جديدة سوف تفتح أفقا أمام التطورات النقدية المعاصرة.
– النقد والبعد الهيرمينوطيقي
إذا كانت الهيرمينوطيقا حققت ثورات في مجالات لاهوتية وقانونية وفلسفية، فإن تأثيرها في المجال الأدبي لم يتبلور بشكل علمي إلا مع المفكر والباحث هانس روبير یاوس” الذي عمل على تحديدها والبحث عن استقلالها وكيفية اشتغالها على النصوص، لأنها الموضوع الأساس الذي شغل المهتمين، بوصفها ظاهرة تاريخية وكونية جديدة، شكلت سماتها الجنينية في رحم ثقافة دينية، ويعزي “ياوس” تأخرها في مجال الأدب نظرا “لهيمنة النماذج التاريخية والتأويل المحايث للعمل الأدبي”(21).
فهذه النماذج المحددة من طرف “ياوس” لم تهتم بالوحدات الثلاثية للعملية الهیرمینوطيقية: الفهم والتأويل والاستعمال، بقدر ما اختزلت نظريتها في البعد التأويلي ملغية من مجالها الفهم والتفسير. وهذا الإهمال هو الذي وسع دائرة الاهتمام من طرف التأويليين، وغير كل الأدوات المستعملة في الدراسة القديمة(22). من هنا وجد “ياوس” مقاما موجبا يقترحه علينا من أجل أن نتواصل معه في النقاش دون أن يفرض علينا ثوابته ونتائجه الإستيتيقية. لأن “ياوس” يبحث في طبيعة الوضعية التأويلية للثقافة الغربية، مشخصا إياها بوصفها مصابة بردة تاريخية ومحاور لبعض المناهج والمدارس، كالبنيوية والشكلانية والماركسية. فالمحاورة إذن هي تأويل منسق لكل هذه الأعمال التي اتخذت بنية إشكالية التفكير، هذه البنية جعلت تخريجاته تنتظم وفقا لمرجعية منهجية واحدة وهي جمالية التلقي تنطلق من ترجمة العمل ثم تنتهي إلى التلقي، فمن جهة الإشكالية النقدية حاول ياوس أن يبين أن المناهج قد دأبت على الاشتغال على مسألة واحدة وجهت دراساتهم، ألا وهي مسألة الشكل (الشكلانية) والمضمون (الماركسية) والبنية (بنية النص)، لأن إشكالية (الشكل- الواقع -البنية) هي الخيط الهادي للثقافة السائدة من الشكلانيين إلى الماركسيين وأخيرا البنیويين ذلك يعني عند ياوس أن تلك الإشكالية تتجلی في إلغاء المحاور التي تتفاعل وتتلقى وتشارك في بناء العمل، لأنها لیست مجرد أداة خارجية للتطبيق، بل عنصرا فاعلا في كل عملية بنائية.
أما “جورج کادامير II.G.Gadammer” فقد وضع الهيرمينوطيقا الفلسفية على أساس وحدة اللحظات الثلاث للعملية الهير مينوطيقية، لأن “ياوس” سلك مسلكه معرفا الهيرمینوطيقا انطلاقا من البعد القانوني واللاهوتي(23) غير أن هذا الحس النقدي إزاء العمليات الثلاث نراه يحن إلى حل ما، حيث يقارب بين المناهج والمرجعيات التي حركت الهاجس التأولي، مثل: “القانون – الأسطورة – اللاهوت”(24). فمظاهر التنوع جعلت التمييز المنهجي والدلالي ينبني على أشكال التحديث من حيث هي درجات في معالجة مشكلة التأويل النصي، وللقيام بذلك “يجب ألا تنسى هوية النص المحتفظ بها أو المتغيرة، هذا إلا أردت أن تبقى في مستوى متطلبات أي هيرمينوطيقا علمية(25) إن “ياوس” لا يعتمد النص وحده بل يعتمد المشاركة الفعلية من طرف القارئ أو الجمهور، وهذه المشاركة تجعل منه فاعلا وليس مستهلكا، ومبدعا وليس ساكنا، وناقدا وليس ناقلا، وثائرا وليس إيديولوجي، بل قارئا ناقدا يعيد النص ولكل مقوماته الفنية والدرامية والجمالية، وهذا الفهم الثاقب هل يتوفر في ناقدنا المسرحي العربي؟. سؤال يبرز الملامح المشتركة لكل فهم كما تقترحها الهيرمينوطيقا الفلسفية، ويتمثل أساسا في العلاقة بين السؤال والجواب، وقد صاغ “جورج كادامير” ذلك بقوله: “أن نفهم يعني أن نفهم شيئا ما باعتباره جوابا”(26).
فالمبدع عبد الكريم برشيد لهذا النص المسرحي من حيث هو جواب ينكشف من خلال السؤال، ذلك طبيعة السؤال تكمن في کونه “يفتح ويبقى مفتوحا كأفق ممكن”(27). ويخلص “برشيد” إلى أن الهيرمينوطيقا الأدبية بدورها تعرف هذه العلاقة بين السؤال والجواب من حيث ممارستها للتأويل، ومن حيث النص القديم في غيريته Alterite، أي بالتعرف على السؤال المركزي الذي يقدمه النص کجواب عنه، وبالتالي إعادة بناء أفق الأسئلة المركزية والاحتمالات والانتظارات المهيمنة في “العصر الذي يندمج فيه العمل الأدبي إلى متلقيه الأوائل”(28). من هنا أن العلاقة بين السؤال والجواب أداة هيرمينوطيقية لا يمكن الاستغناء عنها في عملية تأويل النص المسرحي، ولكن عليها أن تمتلك أداة السؤال والجواب، وأن تختبر حدود قيمتها في التجربة الجمالية للمنصوص المسرحية المدروسة، ولتجد نفسها مضطرة لأن تضع في أساس تفكيرها النظري مفهوما تفترض وجوده، هو الأنظمة التاريخية والفلسفية أثناء تأويلها للنصوص، ولكن دون أن تعالجه بشكل تام لا لذاته ولا لهدف منهجي، ويتعلق الأمر بمفهوم الأفق Horizon، انطلاقا من كونه حدا تاريخيا وفي الوقت ذاته شرطا لكل تجربة محتملة، ومن حيث هو عنصر مكون للمعني…”(29). فالهيرمينوطيقا تضع الأفق في صلب تفكيرها، وكذا السؤال والجواب كجذر يجمع الفهم بالبعد الذاتي بالبعد التخيلي في شكل مقصدية جمالية تراعي خصوصية الجمهور والقارئ. يقول “جورج غاد امير”: “إن الفهم يوصف في أكثر استعارات کادامير شهرة کاندماج لأفق الفرد مع الأفق التاريخي”(30) فالأفق يبقى الجوهر في عملية التمسرح، باعتباره “وجه أساسي في عملية الفهم”(31) والناقد المسرحي بدوره ينبغي أن يعلن عن مرجعيته بإحالتنا على بعد تأويلي جديد يحدد على إثره أفق الانتظار، وهو مدعو لمساءلة النص المقروء أو الملعوب أو الممسرح، باعتباره مكونا كلاميا le composante verbale، أي مجموعة من الإشارات والحوارات والديكور والإنارة التي تتمازج داخل فضاء مسرحي، لتشكل المادة الخصبة التي يتفرد بها هذا العمل المؤول. إن البعد التأويلي الذي يهيمن على النص يؤسس خطابا موازيا يفرض على المحفل الفرجوي الناقد يبقی دوما بعيدا عن المشاركة منذ البذرة الأولى، وهذا يمنح للأحداث والمواقع صبغة مفتوحة تسرد من تلقاء ذاتها، إلا أن هذه الخاصية تبقى نسبية، يقول “ياوس”: “إن من يعتقد في نفسه أن يصل إلى أفق الآخر (الماضي) دون أن يعتد بأفقه الخاص، إنما ينقل الماضي البعيد بمعايير ذاتية تتجسد في الاختيار والمنظور زاعما أنها موضوعية”(32). إذ أن النقد المسرحي يفتح لمادته حوارا خلاقا مع النصوص المعالجة، لخلق نبرة مغايرة في سمفونية الخطاب النقدي، لأن تداخل النصوص السردية التي يهيمن عليها التبئير تجعل الخطاب النقدي ينتج على مستوى التلفظ قيمة جمالية تتمثل في خطاب التناص الذي يستند نظريا على آفاق قرائية التي حددها “ياوس” في ثلاثة مراحل:
1- البعد الأول يسمي الإدراك الجمالي.
2- البعد الثاني يسمى التأويل الاسترجاعي.
3- البعد الثلث يسمى أفق الانتظار(33).
فهذه المراحل تجعل المسرح حوارا يتغيا استهلاك المتعة التأويلية التي يعدنا بها النص المسرحي، حيث يستلزم الوقوف عبر محطات متباينة، تبدأ أولا باقتصاد النص ومرورا بتيمة التمسرح ووصولا إلى المكون النقدي الذي يشتغل بديناميكية داخل الفضاء. فعملية الهيرمينوطيقا لا يمكن تحديدها إلا بالنظر إلى التأويلات السابقة، حتى تتم موقعة التأويل الحاضر ضمن سلسلة متعاقبة من التأويلات، يقول “ياوس” في هذا الصدد: “لا وجود لأفق حاضر في انفصال عن الماضي ولا لأفاق تاريخية يمكن عزلها، بل يمكن الفهم بالأحرى في عملية دمج هذه الأفاق التي ندعي فعل بعضها عن بعض”(34).
فالمسرح البرشيدي لا يقدم نفسه بسهولة باعتباره بنية مفتوحة مبثقة من الإشارات والإعلانات والتوابع، ومن كل الخصائص الرمزية، بحيث يكون الجمهور مهيئا من قبل لنمط التلقي، ابتداء من مرحلة التوقع إلى مرحلة التكيف والتوتر والتخيبيب، وأخيرا مرحلة السخرية أو النقدية أو التغيير حسب مفهوم “حسن حنفي”(35). فالتفاعل بين الخطاب المسرحي والنقد، يجعل من العملية الهيرمينوطيقية الاحتفالية مفهوما انزياحيا جماليا، ولا يكتفي بالاستجابة الذاتية، بل يغير أفق انتظاره وهذا التغيير يشكل منعطفا جديدا في مسيرة التلقي المسرحي والنقدي(36). من هنا نتساءل كيف يمكننا أن نتعامل مع النقد المسرحي من خلال القصور الذي أفرزته جمالية التلقي؟ وكيف يمكننا قراءة تاريخ النقد الاحتفالي؟ وهل يمكن قراءته قراءة حوارية؟ هذه الأسئلة وإن لم تأخذ بعد حصتها من العناية في الدرس والتنقيب، فإنها بدأت مع الدكتور “عبد الرحمن بن زیدان” و”جلال العشري” و”حسن المنيعي” و”نصر حامد أبو زيد…” الذين تجاوزوا هفوات النزعة التاريخية والوصفية، قصد بناء منهج نظري ومحوري مدمج بآليات تغترف من السيميائيات ومن المتخيل، إنه نقد حواري یزدوج بالقراءة وبالنقدية، وبالكتابة وبالتأويل، منهج تتقاطع داخله مستويات معرفية ويلتقي فيه النفساني بالجمالي والاجتماعي بالتأويلي والمسرحي بالتاريخي.
– النقد المسرحي ومسألة الحضور عند عبد الكريم برشيد
إن ضبط النظري الذي يتأسس عليه المفهوم هو الذي يحدد النسق المفهومي الذي يتمرکز عليه، وفي نفس الوقت معرفة مدى إجرائيته وفاعليته الفكرية والثقافية في فلك الغاز البنية الاجتماعية والأدبية بكل حمولاتها الفكرية والدلالية ومكوناتها الفرجوية.
من هذا المنظور يتوخى هذا الحضور الاحتفالي إثارة الفضول في الموضوع، وخلق بعض الأسئلة الجوهرية وعلامات الاستفهام كمؤشر لتوسيع دائرة التثاقف، وكذا تقريب لغة الحوار في شكل حقل ابستیمي، لأن الحضور هو عبارة عن ضبط وملامسة بنيوية واجتماعية بمختلف تجلياتها وتمظهراتها.
فاختيار هذا النمط من المساءلة، له ما يسوغه من الناحيتين الذاتية والموضوعية، نظرا لاعتبارات قد تصل بطريقة أو بأخرى بثقافة الآخر التي مورست عليه، ثم إن هذه الخلفية تعرف هيمنة مطلقة للمحكي الفني والسردي والشعري والمسرحي، حيث يملأ كل جوانب البنية التخييلية، لدرجة يصبح فيها الحضور محاصرا بكل مقوماته وتسلسل أحداثه.
من هذا نعتبر أن مقاربة “الأصل” فوق أرض محایدة، تكون تابعة لمنهج علمي، إلى درجة أن الحضور يدخل في مجال التداول الرمزي والاجتماعي عبر قناة أساسية تتمثل في الخطاب، حيث تتحول الإشكاليات إلى علامات تخترقها أنظمة رمزية وتتداخل فيها مجموعة من الأليات الفنية والاجتماعية، مما استدعى الانصراف نحو الإصغاء لخطاب الآخر وكيف يعمل فينا، لأن الخطاب المسرحي يعيش الهامش، كما أنه ينتمي إلى بنية قابعة خارج الزمن والمكان، لكون الدراسات التي تحمل في طياتها إيقاعات وضوابط تتوسل بمسالك وطرائق، يهيمن عليها الطابع النظري المثقل بالأحكام وبالضوابط المنهجية الصارمة، مما جعل الاتجاهات تأخذ مكانها بين البعد التقويمي والبعد التأثيري وبما أن هذه القضية شكلت فضاءا خصبا للرصد والاقتراب من دلالة الأثر المسرحي، فقد سعى البحث إلى الوقوف عند أبعادها الاجتماعية والمسرحية وشروطها التاريخية ومكنونات اشتغالها الشكلية والتخيلية، متجنبا في الآن ذاته مخاطر النزوع التاريخية للنشأة والتطور. فالسعي وراء الحقائق التاريخية يجعلنا نحس بنوع من الاندماج في شكل سؤال حول كينونة المسرح العربي والمغربي غير أن هذا الرصد التفصیلي يعرفنا ليس فقط على ممارسته وشؤونه، وإنما على الجزء الأكبر حميمية من ذاته، لنتعرف على تعطش المسرحي للمعرفة وللعالم، قصد محاكمته للأمور وطريقة تفكيره بشكل عام.
فالمسرحي يعكس دوما تلك الدهشة التي تصاحب من يقتحم آفاقا غير الآفاق التي اعتادها وأصقاعا غير تلك التي انتمى إليها، وتتسم هذه الدهشة ببراءة مطلقة وانفتاح غير محدود، يخلف كليا عن ذلك التردد والحذر الذي صاحب مثقفي ما بعد الحرب العالميتين. فالمسرحي العربي يرتاد العالم الجديد ويثريه بمثاليات وأحلام رائعة تدفعه للتحرر من الاستبداد، وكذا التطلع إلى إيجاد صيغة أرضية صالحة للتنقيب وللكتابة.
من هنا نتساءل، هل هناك نقد مسرحي عربي؟، إننا لم نفهم هذا السؤال إلى يومنا إلا من زاوية التراث وليس من زاوية المفهوم والوظيفة، فالحصر لا يعطي لنا إلا الانغلاق والتقوقع داخل الشيء، دون الارتباط بالأفق وبالإشكال الذي رسمته التحولات النقدية المعاصرة. إن الارتباط بالماضي ليس إلا مزعم لا نقدي حواري، فلا يصمد أمام المساءلة التاريخية، وإنما هو تقليد التقليد، دفع بأسئلة التراث إلى النهاية. إذن كيف نحرر هذا النقد من البعد الكرنولوجي ومن المطلق؟ كيف يجد النقد في مسألة الهوية والخصوصية أفقه الخاص؟.
لقد كان الناقد في تاريخ النقد الذي تأسس عليه ناقدا ثابتا، أي كائنا لم يجد لنفسه مستقرا، بل هو مضطر في كل مرة إلى استحداث التشريع النقدي الذي يجعل وجوده ممكنا، بيد أن وضعية النقد المسرحي التي فكر بموجبها النقاد، إنما هي الوضعية الراهنة للمثقف العربي، لأن المثقف هو الذي نبت في السلفي وعایش النهضوي، ليتساوی في تلك الأطروحة التي لازالت بمثابة امتحان عسير التحقق ألا وهو إیجاد ناقد مسرحي مختص، لذا تستوجب الممارسة النقدية امتلاك أدوات حفرية، لاستخراج كل المرجعيات المعرفية والنفسية والاجتماعية والفنية، إذ ظهرت العديد من المؤلفات والآراء التي تؤكد خصوصية هذا النقد المسرحي الذي أثر في الحركة الأدبية والفنية، ومن بين هؤلاء: “محمد الماغوط”، “سعد الله ونوس”، “يوسف العاني”، “عبد الرحمن بن زيدان”، “حسن المنيعي”… حيث واجه الناقد المسرحي العديد من القضايا منها: التنظير والتجريب والتأصيل والتحديث… هي قضايا لا تعلو عن التاريخ والزمن. وبالضرورة، فهي تفكر في تكونها من طرف الأنا المفكرة، تريد بديلا للأنا / المتعالية، وهذا الإبراز بمثابة كتابة جديدة وارادة واعية تخترق الكائن، جاعلة من الكائن الإنساني خيارا مستعدا للجرح، ومنخرطا في جوهره، لآن في هذا الوعي تتأسس القراءات وینوجد الفعل العنفي كفكر يخاطر بماهيته، أي يصرف الواقع من ثباته إلى سیرورة يرفع يقينه إلى طور الحقيقة، حتى يحول الوعي بذاته إلى وعي بالواقع. يقول “فتحي المسكيني”: “وبالرغم من ذلك فالفكر يحتاج دوما إلى بعض الفراغ والثقوب والعطالة والاستيلاب والضياع لكي يفكر، إن أشد ما يخيف الفكر ليس الفراغ مثلما كان يقال عن الطبيعة، ليس عدم الكتابة كبطالة فلسفية، بل الموقف من الكتابة نفسها، إن أمية ما هي التي تحكم قراءتنا لكل ما يكتب، الفكر لا يخشى الفراغ الفكر يخشى الامتلاء”(37). فالتفكير مع النقد المسرحي يعني الانخراط في هذا الممكن والمحال والمستعصي، قصد تشخيص كل المفاهيم الرائجة وجعلها تتأطر في صلب القاعدة المسرحية “ونقد مفاهيم جديدة على اعتبار أن الإبداع يتضمن في داخله رؤية جديدة وحساسية جديدة”(38). فالنقد المسرحي ينبغي أن يخرج من دائرة الاجترار والتشبيه وإعادة الجاهز إلى طاولة القراءة والاختلاف والاندماج في أسئلة الحاضر، لأنه لم يعد تابعا للمحاكاة، بل أمسى خاضعا لرؤية الثقافة المرتبطة بالشروط التاريخية المؤطرة؛ فرغم هذا الحكم ظل يتراوح بين جهاز النص وبين الانخراط في مسلسل الواقع من جهة الأسس النظرية والإيديولوجية. فالناقد يحاول الاضطلاع على نحو كلي بطبيعة أسئلة الواقع، بيد أن ذلك يعني في الوقت ذاته، أنه قد يصطدم بصعوبة تبدو أنها أصلية وعبارة عن جملة من المسبقات، إذ كيف يمكن للناقد أن يفكر على نحو حاسم في مسألة النقد بواسطة جهاز إشكالي تؤطره أرضية كلاسيكية، والتي لم نتأسس على أنقاضها علاقة جوهرية بمسألة التحول. إن الغرب طرح السؤال حول ماهية الأنا، وعين ذلك على أنه المهمة التي يجب أن ينخرط فيها الإبداع والناقد لأن وضع النقد في أفق تأصيل إشكاليته بما هي إشكالية عملية جوهرية، جعلت الناقد كما قلنا يطرح العلاقة الموجودة بين الذات والموضوع في بعدها السرمدي، حيث التوحد لا يمكن إلا أن يفتح باب الاحتمال لموضع التناهي، مما جعل الناقد العربي ينتج خطابه كشكل مغايرا، يؤسس العلاقة بينه وبين البعد التركيبي الاجتماعي والسوسيوتقافي فالإمكانية التدميرية لكل المثبطات، جعلت الفعل المسرحي يسخر من نوايا الفكر الكلاسيكي ومنطق الكتابة باعتباره فعلا يفرض إمكانية التفكير على أساس التحرر من كل الإشكالات الاجتماعية، وكذا السعي إلى إخضاع كل المقومات الفنية والمعرفية إلى أطروحة التجريب. بيد أن هذه الإمكانية النقدية لبناء علاقة مفتوحة بين الفكر والواقع وبين النص والعرض والتجريب والتأصيل، علاقة تمتد من بداية الستينيات إلى الصحوة المعاصرة إن صح هذا التعبير، الفعل النقدي هو اكتشاف لكل مظاهر الغياب والإقصاء الذي مورس من طرف المؤسسة بكل دواليبها.
فالتفكير النقدي المسرحي البرشيدي هو لحظة توسط(39) (Médiation) بين اللحظة والمغايرة، وبين المحاورة والحقيقة، حيث يصبح الناقد قابلا للفهم والإفهام في الوقت نفسه أمسى البعد النقدي بمثابة تفكيك للبنية التخييلية. يقول “جاك دريدا”: “يتميز التفكيك عن النقد. فالنقد يعمل دوما وفق ما سيتخذه من قرارات فيما بعد، أو هو يعمل عن طريق محاكمة، أما التفكيك فلا يعتبر أن سلطة المحاكمة أو التقويم النقدي هي أعلى سلطة. إن التفكيك هو أيضا تفكيك النقد، وهذا لا يعنى أننا نحط من قيمة كل نقد أو نزعة نقدية، لكن يكفي أن نتذكر ما عنته سلطة النقد عبر التاريخ(40) هذه المحاولة تروم للحفاظ على المسافة الموجودة بين النص وبين المنظومة النقدية يسمح بإدخال البعد الذاتي على الأطر النظرية المجردة، الأمر الذي يعطي للناقد حركة التنقل بذاتية مركبة تستوعب كل الجماليات، فضلا عن الإحاطة بكل المعارف. لذا نرى أن البحث عن الحضور وعن الأصل مدعاة للتفكير من خلال النكران (الذات) والضد الجاهز، لأن الفعل هو عبارة عن سؤال يتحدث عن إشكالية الغياب في خضم القراءات الميتافيزيقية.
فبالرغم من هذه الإشكالية المحرجة التي هي عبارة عن أخطاء، جعلت الناقد المسرحي برشيد يعيد الذات كمبحث استتيقي ضد التاريخ النهائي وضد أنفسنا، لأن الذات ينبغي أن تفكر في مسألة التعدد بشكل نقدي لا إيديولوجي. ويقول “عبد السلام بنعبد العالي”: “إن النقد الإيديولوجي هو دوما نقد كلي يحشر المؤلف ضمن رؤية وتيار ونظرة إلى العالم، تضم المؤلفات والمؤلفين وتفكر بهم وتذيبهم في نسيجها(41).
إن هذه المنظومة تمدنا برسم حاسم لإشكالية الحضور والاستفهام، ف (هل( في البعد الاستفهامي لا يتطابق مع الممارسة التراثية، بل يأخذ کینونته انطلاقا من الاختلاف والمحاورة في شكل التولید (L’engendrement) الذي ينم عن قوة بلاغية وإيقاعية جسدية؛ تمنح لهذه الأنا حضور الرغبة انطلاقا من مظهرها الفيزيقي ورؤية الافتتان والجمال العرضي. فالنقد المسرحي هو مدخل للعشق والهدم والبناء، وتحول من مشهد غير بصري إلى مشهد بصري، لأن الفعل المسرحي يغدو شرطا أساسيا من شروط التلقي. لذا نادرا ما بني المسرح بدون تلقي وبدون خيال، فالمسرح إذن عالم يضم كل العوالم والأمكنة والأزمنة، عالم ينتج الأصيل ليغاير ذاته بواسطة السؤال، من أنا؟ إنه سؤال ميتافيزيقي الذي حاول الناقد أن يعيد بناءه قصد تقويم كل المسلمات المنهجية التي تؤكد فعل الإحالة. فالمسرح يتغير تبعا لسنة التوظيف وقانون الممارسة، لذا يبقي النص هو الأساس والجوهر، ووسيلة مثلى للتنظيم، حيث تتجدد فيه العناصر الكلية، ويتخطى النص وظيفته السانكرونية والدياكرونية، ويتخطى الديكور واللغة وظيفتهما التزيينية، ويتحول أداء الممثل، من الأداء الذاتي إلى إقناع الجماعة. لذا فالنقد يتغير ويتفاعل مع المحيط الاجتماعي والثقافي. وبالإضافة إلى تفاعله مع كل المكونات الهامشية حتى تنبني السيرورة الكلية، ويحس المتلقي بفرجة تحتمل التعدد، ولا تعتمد التكلف النصي كغاية مثلى. فالنقد المسرحي العربي هو نقد لازال لم يؤسس جنسيته إلا كمفهوم مبني على الغربة والاستيلاب، لأن المقام الخصوصي لابد أن يكون ذا علاقة بواقعه وبأصله. فالمسرح كما جسده المعلم الأول (مارون النقاش) هو مسرح دخيل وليس أصيل، والنقد بدوره دخيل لا أصيل.
فالمساهمة في المعرفة المنهجية من خلال السؤال الاحتفالي هي مسألة ليست سهلة التعريف ولا التحديد السوسيولوجي، فالاقتراب من السؤال يظل يحمل تصوره الميتافيزيقي كقدر يأفل نحو المغيب، حيث يقيم الناقد الأدبي سيرورة أدبية غير مبعثرة ولا متناهية، وتظل تعمل فعلها فيما يقدم من قراءات نقدية، لكن هذا المعطی الميتافيزيقي ظل يحمل موته مع بداية الستينيات، إذ أصبح السؤال المسرحي ليس الإجابة عن العوامل النفسية، بل الخروج من الخارج إلى الداخل، أي البحث عن أشكال التمسرح والتجريب والتأصيل والتحديث والتموقف، لأن تاريخ المسرح العربي في هذه الحقبة هو تاريخ فجوات وانقطاعات، تاريخ يعيد التناقض في جسر الهوية، يقول “دولوز”: “إن الهوية والتشابه أوهام يولدها العود الأبدي”(42).
إن العمل المسرحي البرشيدي ينبغي أن يكون متناغما ومنسجما مع عقلية القارئ أو المتفرج ومع محيطه، لهذا اكتسب المسرح هذه الصفة الجديدة منذ القرن التاسع عشر، وأصبح كل من المؤلف يوزع الأدوار وبإخضاع كل شيء لنوازع الذاتية. هذا لا يعني أن وظيفة المخرج لم تكن حاضرة، بل أيضا هناك وظيفة المؤلف المخرج، حيث تنحصر في نقل النص وتفسيره حسب نظره. لأن عملية الإخراج تبدأ بفهم النص ثم اختيار الشخصيات التي لا علاقة لها بالتمثيل. إذ يقول “فاروق عبد القادر”: “إذ ألف الناس عادة الذهاب للمسرح، فذلك أننا قد اعتدنا طوال أربعمائة سنة، أي منذ عصر النهضة على شكل روائي ووصفي للمسرح، مسرح يقوم على سيكولوجيا”(43).
هذه المقاربة حاولت تخليص القراءة من السطحية ومن النهاية، حتى يبقى المسرح الاحتفالي ذا سلطة لا متناهية، إذ بواسطتها يستطيع الانفلات من أي تحديد يحاول الزج به في القفص، وجعله قابلا لتشريحه ولو صفاته. لأن القراءة الممسرحة تشمل في أن النظرة (La vision) والمنهج، ثم البرهنة على العمل، فهذا ما يجعل من القراءة آلة للوضوح النظري، أي أن القراءة تعمل على تقنين النظرية ولدحض ثنائية “سوسير” المبنية على الدال والمدلول، لذا ركزت الدلائلية البرشيدية على وحدة الدليل، ومقاربة النقد المسرحي کدلیل تجعل منه مفهوما تاريخيا وإيديولوجيا بمعنی واحد ووحيد، معنى حقيقي نهائي. إنها آلة صارمة تضع قواعد صارمة ومحددة لقراءة النص، ويتيح الأسئلة التالية: متى نكون قد امتلكنا شرعية التساؤل؟ هل كان النقد المسرحي العربي دليلا مغلقا؟ وهل سنعتبره مجموعة أو نسقا من الأدلة تشكل فيما بينها لعبة لغوية؟ بأي شيء سنعرف النقد المسرحي، هل بنيته الشكلية أم بتداوله؟ وهل نستطيع دراسته كنسق سيميوطيقي؟.
إن وضع اللسانيات بالنسبة للشعرية والدراسات الأدبية الدرامية عامة، لا يمكن أن تكون إلا كحالة علم مساعد، حيث يكون دوره مماثل لما يلعب علم الأصوات بالنسبة للسانيات نفسها، أي أن اللسانیات يمكن أن تساعد الشعرية بجملة من الأدوات. فاذا سلمنا إذن بأننا لن نتخذ اللسانیات إلا كعلم مساعد لدراسة النقد المسرحي، فهل سنقتصر على الفصول اللسانية ذات الطابع البنيوي؟
داخل هذا الفضاء تتشكل إحدى تجليات بهجة القراءة مادمنا مدعوين إلى استنطاق كل الترسبات النظرية والمنهجية للكشف عن مكبوت الخطاب لتكلمة الملفوظ، لأن آلية اشتغال الكتابة داخل النسق الكلي، تجعل الناقد المسرحي يروم لبنية قيم مفتوحة محكومة بهوس الحفر والاختلاف، وهذا ما يسمح بإدراجه داخل النقد المسرحي العربي.
إن الناقد المسرحي يسهم في بناء جسد مفتوح له رقصته وطقسه وتلوينه المعقلن، جسد يفر من اجترار ذاته، متجاوزا لمسات التأسيس كما شاهدتها تجربة الستينيات، ومتجاوزا قسمات التوليدات الإسقاطية، ليؤسس عالما مبنيا على الحركة والفعل الممسرح. ورغم هذا فالعمل المسرحي لا يكتمل إلا إذا استقبل المتلقي المعني الذي يتحقق بتتابع العلامات الجزئية التي تشكل هذا الكلي، وأن إدراك هذا العمل الممسرح يتم من خلال استمرار دلالي، شكلا خطيا ينبسط أفقيا على نحو تتابع فيه المكونات: فالديكور يتبع الإنارة، والصورة تتبع الحركة، والزمن يتبع المكان…، وفي جانبه الآخر يأخذ هذا التتابع شكلا عموديا يبدأ من المستوى التمسرحي إلى مستوي التلقي.
إن النقد في المسرح الاحتفالي يمثل مكونا من مكونات التعرية، مادام هذا المكون يربط بين النص والعرض، ليستخرج كل الطبقات الغير المرئية، فإنه يتسم بسمات دلالية بوصفها وحدات معجمية، ويغدو انفجارا معرفيا وانفتاحا على الآخر بشكل يحفز على التثوير الجذري للنص، لينقله من أسر الأحادي إلى التعدد. وبهذا المعني تتحول قراءتنا إذن إلى عشق، يتأسس على المغامرة وعلى جملة التطورات الثقافية والاجتماعية والسياسية وهذا التحول يرتد إلى واقع مادي، يتعلق بسقف ثقافي مبنين على المغايرة وعدم التساكن، ويحيل على ما سماه “فوكو” بالثقافة النصية. فالنقد المسرحي العربي إشكالية تربط بين الفكر والواقع وتنظم أدواته من أجل ربط شكله بالإشكاليات المرجعية العالمية، لأن النقد فن مستحدث مثل الأجناس الأدبية، كما يقول “د. محمد برادة”: “إن معظم نقادنا منذ حسين المرصفي، قد اتجهوا صوب المستودع الأدبي والأوربوي، بحثا عن أدوات التحليل والتفسير، حتى عندما حاولوا إعادة تقويم روائع التراث العربي…”(44)، هذا الاندماج التقويمي جعلنا ندرك أن العلاقة بين الأنا والنحن، هي علاقة إغواء إيديولوجی؛ بحيث يصبح حضور الآخر كبعد استعاري يجرد الأول من سياقه التاريخي ليوظف سياقاته التي تؤسس الثقافة البديلة. يقول “فؤاد أبو منصور”: “إن الغرب مرأة تساعدنا على رؤية أنفسنا في السلم الحضاري، وتحدد لنا على أي درجة نقف، وكيف سنتوجه… وأية أدوات سنعمل لاستكمال مشروع الحضارة…”(45). هذا الطرح لا يحل الإشكالية المنهجية في النقد المسرحي العربي، بل يظهر لنا وكأنه ضرب من المصادرة. بيد أنه في الحقيقة أن الثقافة لا تتنامى ولا تزدهر إلا بالانفتاح والاستنطاق بعيدا عن التعسف والتعصب يقول “عبد الكريم برشيد”: “إن بؤس المسرح العربي يكمن في الاقتباس، اقتباس النص والتمثيل والإخراج والمفاهيم والمقولات والمصطلحات والنظريات والبنيات المسرحية، وأخلاقيات الاحتفال المسرحي وتقاليده المختلفة. إن كل ممارسة – نحن – الآن – هنا، له وجود سابق عند الآخرين هناك، وبذلك كان إنتاجنا المسرحي في حقيقته مجرد إعادة إنتاج، تماما كما نفعل في تركيب السيارات والأجهزة العلمية الدقيقة (46).
وانطلاقا من هذه المنظومة الفكرية، نرى أن المبدع برشيد ينبغي أن يتجاوز ذاته لينتج كما يسميه “کلودمان” الأبنية العقلية المتجاوزة للفرد، أي الأبنية العقلية لمجموعة اجتماعية، وما يقصد “كولدمان” بهذه الأبنية العقلية هي بنية الأفكار والمطامح التي تشترك فيها مجموعة اجتماعية، والتي تصل إلى أرقى تعبير، لأن كبار المبدعين والمسرحيين والنقاد هم الأفراد المميزون الذين ينقلون إلينا رؤية العالم عند طبقة أو مجموعة التي ينتمون إليها ويصوغونها بطريقة واضحة فالقراءة النقدية تغدو حداثة حفرية وانفجارا معرفيا وانفتاحا على عوالم أخرى، بشكل يحفز على التنوير الجديد وينقل كل مرحلة نقدية من أسرها الأحادي إلى المتعدد والمنفتح، بهذا المعنى تكون القراءة النقدية لهذا المبحث عشقا يتأسس على تبعثر وتشتيت المعاني وتوليد مفاتيح لترصيد طبقات جديدة داخل المتن المدروس، فالمسرح هو تعنيف لليومي ومشاكسته للحاضر، لأن الإبداع ليس سوى لذة ومتعة ينتج نصفه، وهذا ما قاله “ماشيري”(47) وجماعة “تيل كيل” وغيرهم، هذه اللذة هي عبارة عن دائرة معرفية ونقدية تتجاوب فيه جملة معارف ومناهج حركية، ويستطيع الناقد أن يطرح بعض الأسئلة حول اللذة والمحاكاة والتطهير.
فالدعوة إلى قراءة العمل المدروس، لابد أن تكون قراءة موضوعية من أجل استغلال ما يمكن تسميته بالواقع المزدوج، إذ لا يمكن أن تقول إن النقد المسرحي العربي نقدا شموليا، بل هو نقد يحاول أن يتجاوز هذا الوضع، وذلك بوضعة الذات الفردية ضمن كلية اجتماعية تتمتع بأفضلية وأحقية جديدة. فعلاقة الناقد بالنص، لابد أن تكون علاقة نقدية ومعرفية، لا تقف عند حدود الامتثال أو التماثل أو الانعكاس أو التأثير، بل لابد أن تعرف الواقع كما يرى “ماشيري”، وأن هذه المعرفة هي التي تؤكد بصورة رئيسية على الدور المعادي والانتقادي للعمل المدروس الذي يعتزم بناء قوانينه.
والنقد المسرحي عند برشيد هو عبارة عن تيار فكري مبني بصيغة منهجية تسمح بإنتاج عدة طروحات تضع الإنسان والعالم والفن في ميزان التزامن والتعاقب، من أجل خلق زمن انحرافي، ويقول “عبد الكريم برشيد” في هذا الصدد: “إن المسرح هو الواقع الممتلئ باللاواقع، إنه الكائن الذي يحمل الممكن والمحتمل والمحال، إنه لقاء المحسوس بالمتخيل، وتداخل عالمي الغيب والشهادة، إنه الذات في إطار التحول والتغير والتبذل. الذات في انتقالها ورحلتها من الأنا إلى الأخر، من الفرد إلى الجماعة، ومن الحس إلى الحس المركب، الذات في كينونتها الكائنة والممكنة والمحتملة والمستحيلة)48).
– القراءة النقدية ومسألة التأسيس عند عبد الكريم برشيد
إن النقد عبارة عن مراجعة جذرية للخطط والسياسات والأفكار التي بلورت هذا الإخفاق، وقادته إليه، إذ لا يمكن لممارسة نقدية مسرحية أن تولد ما لم تستوعب شروط فعل التثاقف، ولن يتمكن النقد من القيام بدوره، وتحديد حضور المركز فيه، ما لم يضع نصب عينيه هدف تحقيق حركة جذرية، وممارسة إبداعية مغايرة. وهذا يتطلب التزاما بالأدوات وبالمبادئ الاجتماعية بكل مفاهيمها، كالطبقة – التاريخ – الاقتصاد… كل هذه المفاهيم ليست معطى نهائي، بل تتحدد باستمرار مع التطور النقدي الجديد، ومع التلاقح الثقافي، مما يخلق تاريخا للاستمرارية بمفهوم “فوكو”، ويعطي للمفاهيم منعطفا جديدا يغاير كل استراتيجية غير إصلاحية. فالعودة إلى الماضي تجعل الناقد يستوعب البعث الفكري العربي، ولا يقف مباشرة عند المصدر الغربي، وليس المهم الحديث عن كينونة نقدية عربية، بل اعتبارها منتجات الإبداع والحداثة، ولذلك من الطبيعي أن تتطور المفاهيم بكاملها إلى حركة نقدية على جميع الأوجه، وتتحرك الحداثة ضد السلب الحياتي. فمعيار الثقافة النقدية المسرحية عتبة تاريخية واجتماعية كان طابعه هو التمكين لهذه النخبة المثقفة من الفهم والهيمنة على كل دواليب التحليل والتفسير، وكذا خلق إشكالية جديدة تعكس الصراع الجديد بين النخب الاجتماعية والنقدية.
إن التطور الذي عرفه النقد المسرحي من خلال محاولة اندماجه في القوالب والمعايير العلمية من جهة، ومن جهة ثانية خلال تفسيراته المتكررة للتطبع بالصيغة الإبداعية، جعله يؤسس بعض المفاهيم التي تدفعه إلى خانة الأجناس القائمة على علامة البصر. من هنا يطرح السؤال الذي ذكرته سالفا، هل يستطيع النقد المسرحي أن يؤسس كينونته بعيدا عن الأخر؟ في إطار هذه الأسئلة التي تفرزها مجلة هذا النقد المسرحي، تطرح كذلك مسألة النقد بالمناهج، وبالتحولات الاجتماعية والإبداعية بشكل عام. فالناقد المسرحي رغم أنه يعيش ذاته، فلابد أن ينطلق منها ليعترف بمحدوديتها في سبيل نموها وتطورها وتغيرها، ولا ينبغي تعلقه بالحاضر حاضرا لتدمير ذاته، والتضحية من أجل نقل الآخر كجماعة وكحضارة متميزة. فالقيود قياس غير نهائي، ومراقبة مزدوجة يحفظان التوازن والإيقاع الحسي والحدسي، ويضمنان له حركة التواصل بالحركة التاريخية، يقول “برهان غليون”: “يعيش الوعي الذاتي العربي ممزقا بين صورتين، تنهل الأولى من الشعور الأقصی بالدونية، وتنقلب إلى رفض للذات واحتقارها واستصغار قيمتها وتجریدها من كل صفاتها الإنسانية، وتتحول في أحيان كثيرة إلى ما يشبه الرغبة في تدمير الذات وخروجها من جلدها، وخجلها من نفسها وتشويهها المتعمد والمقصود لذاتها، والتلذذ في تعذيب النفس والاقتصاص منها والانتقام، وتنهل الثانية من الشعور المناقض بالتفوق والأسبقية الحضارية والروحية، حتى أصبحت العنترية قيمة ذاتية ومنهجا فكريا، وأصبح مديح الذات والإفراط في التظاهر والادعاء عطاء للشعور بالدونية وتعويضا شكليا عن انعدام الفاعلية والمصداقية”(49)، وتأسيسا على هاتين الحقيقتين، يتوخى هذا المبحث الانطلاق من أسئلة مركزية تشكل الرؤية المنهجية التي يرغب هذا الناقد السير في ظلالها، والفرضية الجوهرية المتحكمة في جل عناصر الموضوع، إذ كثيرون هم الكتاب والنقاد الذين يعترضون على وجود تأثير الواقع على النص المسرحي، فيرون أن ربط القيم الفنية بالاجتماعية لا ينبغي أن تقف عند الانعكاسي أو التماثلي أو العرضي، بل هي مدارة تعبيرية عن الصيغة الخيالية لواقع يتربط بالأثر الأدبي والنقدي جدليا. فمعرفة كيف تقرأ وكيف تتلقى رسالة ما؟ ليست فقط مسألة بسيطة، ولكنها قضية إبستيمية، لأن الدراسة الحقيقية للتلقي المسرحي والنقدي، والتي تهتم جوهريا بكل مقومات البعد الاجتماعي والخيالي والفني والذاتي ليست ممكنة إلا إذا فهمنا المناهج النقدية والحوارية والسوسيولوجية التي لا تقفت عند إشكالية كيف، وإنما عند إشكالية لماذا”(50).
فالنقد المسرحي إذن يبحث عن ذاته، ويرغب في تأسيس عالمه والتخلص من كل البراتين الماضية والذاتية، وقد نتج عن هذا التلاحم المعرفي الذي ميز الكتابة المسرحية العربية من الانخراط في النشاط، أي ضمن سلسلة من الأفعال الفكرية المتشابكة، انخراط يكاد لا يؤجل فحولته وأواصره الذوقية، بل يحل الذاتي في التاريخي، والذوقي في الجمالي، والنصي في المعرفي، والسمعي في البصري، ليكشف عن الصياغة اللغوية والموازية التي أبدعها المسرحي، يقول “نجيب العوفي”: “ليس لأنه يضمها كلها فحسب ولكن لأنها بنسقها أحسن تنسيق ويشغلها لفائدة العرض المسرحي(51).
فالمسرحي برشيد هو متعوي يقرأ ذاته من خلال ذاته، وتثمين لنكهة الضد والتدمیر والنكران والنقد يعيش من إنكاراته ومحوه قصد إفشاء حقيقة المتعة المجهولة أحيانا، ويضيء آثار الماضي ولكن لا يبعدها، بل يجعله يبحث عن “الخلفية التشكيلية للإنتاج الأدبي والفني، وتختزل جميع عناصر العمل في جماليته”(52).
والناقد المسرحي برشيد يطرح مجموعة من الإشكاليات على أنماط الحياة، بحيث يصعب الفعل فيها بالسهولة التي قد تصورها البعض على اعتبار أن التركيبة المفهومية لا تكاد تستقر على تصور واحد، حتى تنتهي إلى الموت. إن النقد المسرحي تغير وتفاعل مع كل المعطيات والتاريخ، ومع معطيات ثابتة كالنص. إذن نحن أمام الثابت والمتحول، غير أن هذا الحصر “النهائي” يستدعي إذن تدمیره من الداخل، لأن في النص لا يتكلم إلا القارئ وحده، وهذه التعددية المفتوحة تلغي المطلق، وتقر بالبنية التي تعتبر عضوا من أعضاء النقد المسرحي، والتي تجعل من النص ليس عبارة عن مخزون نفسي واجتماعي، بل تحوله إلي وقائع ممكنة، مما يعطي لهذه الممارسة النقدية التأويلية بعدا حيويا “لا يعني فقط مجرد قدرتها على الحياة، وإنما تعني القدرة على مسايرة الحياة والموت في نفس الوقت، مثل جسم الإنسان يتطور ويتغير بتطور ذاته من كل النواحي”(53). فالنقد المسرحي العربي حسب برشيد ما يزال عبارة عن مشروع، وسيظل على جدار يتحدى الواقع المبني من طرف المؤسسة. لأن النقد المؤسساتي مفروض من خلال إيديولوجيتها التي طالت المجالات الاقتصادية والسياسية والفنية والناقد المسرحي مرغم على كشف النقاب عن العوامل التاريخية والاجتماعية والحداثية المناوئة للوجه الآخر. من هنا يمكن القول “إن ليس كل قراءة نقدية إبداعية بالضرورة حداثة، لأن للحداثة وظيفة زمنية تعبر عن المعاصرة العاصفية لبعض الأشياء ولأن مميزات هذه المعطيات الثابتة، لا تكمن قيمتها إلا في أدواتها الصيغة هي التي ستساعد الناقد المسرحي على الإمساك بكل التعبيرية”(54). فهذه الصيغة هي التي ستساعد الناقد المسرحي على الإمساك بكل ممكنات النص، كدلالة وكمفهوم رمزي وإيحائي، ومعجمي ولغوي. وكل هذا يجعل العرض لغة نقدية تملك جهازا مفاهيميا وأدوات إجرائية قادرة على إخصاب الفعل المشهدي. وعلى الرغم من هذا التثمين على أهمية هذا التخريج النقدي، فإن الوعي يكون صعبا في معرفة الخلفية المرجعية التي تحضر في ذاكرة الناقد، لأنه لا يتعلق بالظاهر، بل يتضمن التمرد من أجل إقرار الوعي الواقعي. لأن النقد المسرحي ينبغي أن يتضمن ما هو تدميري وإقصائي، حيث لا يسعى إلا التأسیس والتجريب من خلال الماضي، بل من خلال الواقع الممزق على التاريخ؛ فالأمر يتعلق إذن بنقد النقد المسرحي، لأن تاريخه يكشف دوما على أن التحولات المنهجية والذاتية والمعرفية قد تعاقبت مع ما يعرف بالثورات الإبداعية والحداثية، كالرومانسية والانطباعية والواقعية والحداثية والوجودية، بل بكل “الهزات التي حدثت في التاريخ الأوربي قاطبة، حيث شملت هذه الهزة المعاصرة الأمور السياسية والقيم الاجتماعية وكذلك الآداب والفن…”(55). فالنقد المسرحي العربي حسب برشيد يتخذ دوما موقفا من الحاضر كتعبير عن رفض لما يجري أمامه، ويربط نفسه بالأزمان التاريخية العربية وجعلها تهرب إلى الأمام لتستقطب العقلاني والإيديولوجي، وهذه الإبانة إذن تستمد مبرراتها من التحولات الاجتماعية العامة التي طالت الميادين العلمية والتجريبية، تلك التطورات والتغيرات التي أدت بالناقد المسرحي إلى الرغبة في التجاوز واستعادة إنسانية الإنسان، وتأهيل هويته التاريخية ضمن الهويات العالمية، ومن خلال إلغاء الامتدادات الماضية وإلغاء كل الفواصل الاستبدادية وكل ما “يفلت من زمانه نتيجة انقطاع التاريخ ووقته”(56). هذا الوعي لم يستطع أن يبني أفقه الجديد الخصوصي، بل انخرط في الاستمرارية التركيبية التي تصف الحدث بوصفها سياق اجتماعي مرتبطا بتكوين الذات والكيان السياسي، إنها أساس الانخراط في مستوى منهجي مبني على تكوين نظام اجتماعي ونسق مرجي وهو تكون يتم في خط التاريخ بكل رموزه المكونة من علامات وإشارات صريحة وضمنية.
تتجاوز وظيفة النقد المسرحي مسألة إبراز قيمة خصوصية، قيمة تميز وضعية نقدية عن أخرى، وهي لا تمتزج مع التفسير والشرح، لكنها تعين حدودا لكل تداخل غير علمي وموضوعي، مشيرة من جهة إلى ما يعود إلى ميدان المسرح، ويصنع الرؤية خارج كل المعايير القديمة، ومشيرة من جهة ثانية إلى ما يبقى ميدانا للتأويل والحوار والمساءلة هكذا أمسى الوضع الراهن مصدرا للعطاء الشرعي، للنظام التأويلي واختراقا للنظام الاجتماعي. وهذا إذن يشكل منطقة النشاط كما قلت، حيث تتم فيه محاكمة كل الوعي الذي لا يرتبط بالتطورات التاريخية والابتكارات الفنية، ويسمح لنا بمعرفة النزاعات الفكرية والإبستيمية، إنها رحلة دفاعية للنظام الغير المؤسساتي، تدعو إلى إعادة تنظيم القراءة والآداب تماما كالقوة المكتوبة في جسد النص، بل يجرد اللغة ويعطيها قدرة سحرية على فك كل الطلاسيم الرمزية والاستعارية. لهذا قال “أدام شاف A.Schaff: “يظهر أن الفلاسفة قد نسوا هذا الفعل البسيط، وهو أنني عندما أدخل إلى المطعم وأطلب لي وجبة طعام، فإنني لا أريد بهذا أن تتراتب كلماتي بعضها ببعض لتكون نسقا، ولكن لتكون فاعلا لظهور الطعام… إن النظريات الرمزية لبعض الفلاسفة المعاصرين قد نسيت الهدف البسيط والعلمي للكلمات، وتاهت في نوع من الصوفية الكانطية الجديدة”(57). لقد فهم الناقد المسرحي برشيد مشروعية النقد، منتهيا إلى قيام قراءة زمنية على أساس قواعد لغوية ترتكز في أساسه على قواعد تمفصلية وإسنادية ودلالية؛ وكذا على التجريدات الرمزية والارتباطات الصورية إنه غالبا ما ترتبط الأمور بالمستويات الخارجية، كالإنسية والتفكيكية والسيميائية، لكن رغم هذا التلاقح لا تشكل إلا صورة مبسطة التي تجعل الناقد ينظر إلى النصوص الدرامية ليس كعبادة تزامنية، بل على شكل تناغم إيقاعي يغاير البنية الإبستيمية ليعطي في النهاية مشروعية موضوعية.
هذا الميل اللامشروط لإثبات النظام، جعل الناقد المسرحي برشيد كما قلت ينسج من داخل الذات المتخيلة فواصل وأمكنة لا ينبغي مطابقتها بشكل وظيفي، بل تتقاطع لتتحول إلى رافد مفتوح في صيغة غير مطابقة لموضوعية غير إحيائية، مبنية على تحويل مقابلة حي / ميت. إن هذه الصيغ النقدية غير منفردة بإرادة ذاتية وغير موجودة في أفق ثابت، لأن النقد لا يبقى معزولا ومنفصلا، بل يتحرك بشكل أكثر اتساعا في المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمجال السياسي والإيديولوجي…”(58). فهذه الأطروحة اعتبرت نفسها قاعدة تكتسب وضعيتها انطلاقا من مجموعة من الأسئلة التي تنتمي إلى دائرة المسرح، لأنها محاولة لإعطاء جواب على وضعية النقد المسرحي، وكذا على توازن بين الذات والموضوع.
إن اختلاف الناقد المسرحي برشيد مع الثابت والمطلق هو عبارة عن نقد للمضامين الكلاسيكية والنهضوية التي ليست انعكاسا للوعي الجماعي. لذلك يكون النقد فعلا وممارسة بيداغوجية تسمح بإخراج كل الترسبات الماضية في شكل فعل إدراکي ودرامي، ولأن الاختلاف يحمل رؤية كونية ولا يندمج مع المجتمع الاستهلاكي”(59)، بل يعمق الرؤية ويربط بين كل القوى والتنظيمات التي تشكل المجتمع الشامل لذا فالعمل النقدي المسرحي يعطي الأجوبة على الوضعية الراهنة، ويتطلع نحو خلق توازن بين الذات الفاعلة والموضوع المعالج، لأن هذا التوازن لا يتحقق بين الوعي الشقي والوعي الممكن، ولأن هذا الوعي ليس رؤية جامدة.
ومهما يكن من أمر فالمبدع عبد الكريم برشيد هو طود عظيم الذي يقف أمام مبدعات الفن الدرامي موقف الفيلسوف المتأمل في هذا العالم الأخرص لكي يعيد النور إلى هذا الكون الميؤوس برؤية احتفالية وبلغة إيروسية لتتلائم مع جنسية الوجود، والإنسان.